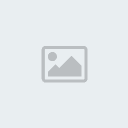بداية لا بد من التمييز بين كل من النص والتراث المعرفي الإسلامي والفكر
المتعلق بهما. فالنص الديني هو العنصر المؤسس لكل من التراث والفكر
الإسلامي. والتراث المعرفي هو كل ما وصلنا من هذا الفكر. لكن الأخير أعم من
التراث لزيادته عليه بالفكر الإسلامي المعاصر، وكلما صار الأخير تراثاً
كلما زاد عليه الفكر الإسلامي بفكر معاصر آخر، وهكذا يظل الفكر الإسلامي
قابلاً للتحديث والتجديد، وهو ما لا يصدق على التراث بإعتباره أمراً قاراً
مقارنة بعموم الفكر.
وهنا نتساءل: ما هي خصوصية الفكر الإسلامي؟ أو ما الذي يميزه عن غيره من ضروب التفكير؟
قبل الإجابة على هذا السؤال لا بد من أن نعرف بأن خصوصية أي فكر تعتمد
على ما يستند إليه هذا الفكر من مصادر معرفية منضبطة. وهي على نوعين
متلازمين لا غنى لأي فكر أو علم من أن يرجع اليهما للإنتاج والتوليد
المعرفي، كما يلي:
1ـ مصادر ذاتية: وهي تشكل خصوصية الفكر المعني،
وبدونها ينتفي ذلك الفكر. وتمتاز بأنها تحمل «إعتبارات معرفية» خاصة (غير
مشتركة) لدى تيارات الفكر المختلفة.
2ـ مصادر عارضة: وهي ليست
ذاتية، أو ليس لها خصوصية الفكر المعني، لكنها قد تلعب دوراً أعظم من
المصادر الذاتية نفسها. وتمتاز بأنها تحمل «إعتبارات معرفية» قد تكون
مشتركة أو خاصة.
والمقصود بالإعتبارات – كما وردت في النوعين
السابقين للمصادر - ليس المفهوم الضيق الذي استخدمه الفلاسفة المسلمون،
حينما قالوا: لولا الإعتبارات لبطلت الحكمة أو الفلسفة (1)، وكانوا يقصدون
بها تلك الإعتبارات العدمية كما وظفت لأجل تبرير نظرية الفيض والصدور. إنما
المقصود بها الدواعي والأدلة التي تتولّد عنها النتائج المعرفية. ولهذه
الدواعي والأدلة طبائع مختلفة، إذ قد تكون الطبائع دينية، أو علمية؛
كإعتبارات مبدأ البساطة والتجريب، وقد تكون وجودية كإعتبارات مبدأ السنخية
(أي علاقة الأصل والشبه). فالاستدلال على صدور الواحد عن مبدأ الوجود الأول
- مثلاً - مستمد من منطق السنخية، ومثله القول بكون العالي يحمل صفات
السافل على نحو أكمل، وتنطبق هذه الإعتبارات على الإعتقاد بازلية الصنع
ونفي البداية المحددة لخلق العالم، ومثل إعتبار الفلاسفة بأن كل مجرد يعقل
ذاته وغيره؛ إستناداً إلى كونه فعلي الوجود من دون حجاب المادة المانعة
(2). فجميع هذه الإعتقادات مستندة إلى إعتبارات خاصة تتعلق بمنطق السنخية
لدى الفلاسفة.
لكن قد تحمل الإعتبارات دواعي وأدلة مشتركة، بمعنى أنها موضع ثقة جميع الدوائر المعرفية. ويمكن تحديد الإعتبارات المشتركة بكل من:
1ـ إعتبارات حقائق الواقع الموضوعي.
2ـ الإعتبارات الرياضية الثابتة.
3ـ الإعتبارات المنطقية الواضحة كمبدأ عدم التناقض.
4ـ الإعتبارات العقلية المشتركة كمبدأ السببية.
5ـ الإعتبارات الوجدانية المشتركة كالتسليم بحقيقة الواقع الموضوعي العام.
ويمكن عدّ جميع هذه الحقائق المشتركة ثابتة باستثناء الأولى، بإعتبارها نسبية وتخضع لإعتبارات منطق حسابات الإحتمال والترجيح.
6ـ
كما أن هناك نوعاً آخر من الإعتبارات المشتركة يخص قضايا القيم الأخلاقية،
وهي وإن بدت ثابتة في عدد من القواعد الكلية، مثلما عليه قاعدة العدل، إلا
أن مصاديقها متأثرة بما عليه طبيعة الواقع وتغيراته، لهذا فقد تفضي بعض
المصاديق إلى أن تكون ذات إعتبارات خاصة غير مشتركة. كما قد تتزاحم القواعد
عند تضارب مصاديقها مع بعضها بما يمكن أن نطلق عليه (تزاحم القيم)، كالذي
يحصل أحياناً بين قاعدتي الصدق وحفظ النفس المحترمة (3).
ومن حيث
مصادر المعرفة أنه إذا كان العقل والواقع يفضيان تارة إلى إعتبارات مشتركة،
وأخرى غير مشتركة، فإن الأمر مع النص الديني يختلف، إذ أنه لا يسفر إلا عن
إعتبارات خاصة؛ رغم أنها قد تكون مدعومة بإعتبارات مشتركة من العقل أو
الواقع.
ويمكن تطبيق فلسفة الإعتبارات على المجالات الإنسانية
المختلفة، كالنواحي النفسية والإجتماعية والحضارية وغيرها. فكل طرف في هذه
النواحي يرتبط مع الآخر بإعتبارات ذاتية وعارضة، كما ويرتبط معه بإعتبارات
خاصة ينفرد فيها الطرف لنفسه، وإعتبارات عامة يشترك فيها مع غيره. فمثلاً
أن الحضارات العالمية تختلف فيما بينها بنواحي بنيوية خاصة، يمكن أن تميز
حضارة ما عن أخرى، لكن مع هذا الإختلاف هناك مشتركات تجمع بين الحضارات
وتجعلها أقرب إلى النزعة الإنسانية العامة بما تحمله من قيم متقاربة في
نواحي عديدة، ومنها القيم الأخلاقية العليا.
ومثلما تتصف المصادر
الذاتية بالثبات والإتفاق بين المنتمين للفكر المعني، فإن المصادر العارضة
يسود فيها التغير والإختلاف. فمثلاً في العلم الحديث للطبيعة تُعد التجربة
والإختبار أبرز محددات المصادر الذاتية لهذا العلم، لكن يضاف إليها مصادر
عارضة بعضها ميتافيزيقية وأخرى تتعلق بما يطلق عليه الحدس والخيال، أو غير
ذلك. وبالتالي فلو أن المصادر العارضة تغيرت أو انتفت فإنها سوف لا تغير من
طبيعة خصوصية العلم الطبيعي وهو أنه قائم على الإختبار والتجريب، بخلاف
الحال فيما لو انتفى الإختبار كلياً، حيث أن ذلك يزعزع الطريقة العلمية
بأكملها ويجعلها نمطاً آخر من التفكير (4).
وتتحدد المصادر الذاتية
للفكر الإسلامي بالنص أو الكتاب والسنة، وإذا كانت السنة شارحة للكتاب
وتبياناً له؛ فسيقتصر الأصل على الكتاب. أما المصادر العارضة فتتنوع وتختلف
بحسب الفرق والإتجاهات، ومن هذه المصادر العقل الكلامي والعقل الفلسفي
والذوق الكشفي، وكذا القياس والاستصلاح والإستحسان، وغير ذلك من المصادر
والإعتبارات.
ولو عدنا إلى المصادر الذاتية فسنجد أن أبرز قضاياها
المعتبرة هي نظرية التكليف، لكثرة ما تشهده من القرائن الدالة عليها، وهي
من حيث كونها أبرز القضايا فإن ذلك يجعلها المحور الذي يدور حوله الفكر
الإسلامي والديني عموماً، وبالتالي فإن هوية هذا الفكر محددة بهذه النظرية.
وتتضمن
نظرية التكليف أربعة محاور هي موضع إتفاق المسلمين إجمالاً، وإن اختلفوا
حولها تفصيلاً، وهي كما عرفنا بالتحديد: المكلِّف والمكلَّف ورسالة التكليف
وثمرة التكليف.
لكن إذا أخذنا بإعتبار أن كل فكر وعلم يمكن تقسيمه
منهجياً إلى نوعين من الفكر: أحدهما (في ذاته)، والآخر (متحقق)، فسيصبح
الفكر الإسلامي بما هو في ذاته معبّراً عن تلك الهوية المجملة من نظرية
التكليف، وأنه بهذا الشكل يحمل الإعتبارات الذاتية لا العارضة، لكنه من حيث
كونه فكراً متحققاً فذلك يعني النظر إليه من حيث تجسده في التراث المعرفي
فعلاً (5). وتعد الإعتبارات العارضة العامل الأهم الذي يقوم بتحديد طبيعة
الفكر المتحقق. فعليها يتنوع الفكر ويتجدد، بل وبها يصبح الفكر قائماً على
الجمع لا الطرح.
لذا فالفضل في تعدد الفكر الإسلامي يعود - في
الغالب - إلى الإعتبارات العارضة، ومن ذلك أن أغلب الطرق المعرفية لهذا
الفكر قائمة على الإعتبارات العارضة لا الذاتية. لذلك أخذت نظرية التكليف
تقرأ - تبعاً للإعتبارات العارضة - برؤيتين متعارضتين في مرآتين مختلفتين
تمام الإختلاف. ونقصد بذلك الفهم المتعلق بنظرية التكليف تبعاً لنظام
المتشرعة كعلماء الفقه والكلام من جانب، والفلاسفة والعرفاء من جانب آخر،
ففي الغالب أن كليهما اعتمد على الإعتبارات العارضة.
وبعبارة أخرى،
أنه من الناحية المنطقية ينقسم الفهم الديني إلى نوعين مختلفين من
الإعتبارات، هما الإعتبارات الذاتية للفهم كما تبرزه الدائرة البيانية
(النقلية)، والإعتبارات العارضة له كما يتجلى لدى الدوائر المعرفية الأخرى.
وعلى
العموم أنه لما كان لكل علم إعتباراته المختلفة، وأن بعض هذه الإعتبارات
ذاتية والاخرى عارضة، لذا فمن المتوقع حصول درجات وأنواع مختلفة من
التعارض، فقد تتعارض الإعتبارات العارضة مع بعضها البعض، كما قد تتعارض
الإعتبارات الذاتية مع بعضها، وكذا يمكن أن تتعارض الإعتبارات العارضة مع
الذاتية، وقد يمتد التعارض ليكون بين الإعتبارات العارضة من جهة، والحقائق
الأصلية أو حقائق الموضوع الخام - كحقائق النص العامة مثلاً – من جهة
ثانية. فالإعتبارات العارضة قائمة بدورها على موضوع خام آخر ليس هو ذاته
الذي تقوم عليه الإعتبارات الذاتية، الأمر الذي يعني وجود مدارات مختلفة من
التفكير يتنافس بعضها مع البعض الاخر، ومن ذلك التنافس بين مدار التفكير
العارض الذي تنشأ عليه الإعتبارات العارضة، ومدار التفكير الذاتي الذي تنشأ
عليه الإعتبارات الذاتية، وحيث هناك مداران للتفكير، أحدهما ذاتي وآخر
عارض، أو قل أن لدينا موضوعين كلاهما يتصفان بالخام، ولهما حقائقهما
المنكشفة المستقلة، أحدهما ذاتي، والآخر عارض، فهذا يفضي إلى حصول نوع من
التنافس وربما الصراع والصدام، حيث لكل منهما إعتباراته الخاصة، وهي
الإعتبارات الذاتية والعارضة. وقد يفضي الصراع إلى أن يكون صداماً بين
الإعتبارات العارضة وحقائق الموضوع الذاتي، ومن أبرز الشواهد عليه ما حصل
مع النظام الفلسفي والعرفاني، حيث أسفر التفكير ضمن مداره الوجودي العارض
إلى نتائج لا تتفق مع موضوع النص الخام أو حقائقه الأصلية (6).
وبالتالي
فالمشكلة - هنا - ليست في النزاع الحاصل بين الإعتبارين الذاتي والعارض
للفهم والتفكير، إذ كلاهما يعبّر عن فهم وتفكير إجتهادي، إنما المشكلة في
الصدام الذي قد يحصل بين التفكير العارض من جهة، وبين الحقائق الأصلية
للموضوع الذاتي من جهة ثانية. مثلما قد يحصل الصدام بين التفكير الذاتي من
جانب، وبين الحقائق الأصلية للموضوع العارض من جانب آخر. فالتفكير الذاتي،
وهو في قضيتنا عبارة عن التفكير البياني، قد يتحول إلى ما يشكل صداماً مع
الحقائق الأصلية للموضوع العارض؛ كالعقل والواقع والوجود.
ومن
الناحية النقدية، أن جميع الطرق المتحققة للفكر الديني، بإعتباراتها
الذاتية والعارضة، قد عانت من مشاكل مزمنة أساسية ثلاث، كالتالي:
الأولى: أنها لم تمارس المراجعة النقدية المتواصلة لفحص مفاهيمها ومقولاتها، لكونها من المذاهب الدوغمائية التي لا تشكك في مقالاتها.
الثانية:
أنها غيبت الإعتبارات الخاصة بالواقع، فحتى الإتجاهات العقلية كانت
إتجاهات تجريدية، أو أنها تعاملت في الغالب وفق العقل القبلي وليس البعدي،
بل لم يحصل آنذاك تمييز بين هذين النوعين من العقل.
الثالثة: أنها
إستندت في الأساس إلى الإعتبارات المعرفية الخاصة دون المشتركة. بل وأن
إعتباراتها والنتائج المترتبة عليها كانت تجريدية في كثير من الأحيان،
الأمر الذي يصعب إخضاعها للإختبارات الواقعية المباشرة. وهذا يعني أنها
تقوقعت ضمن دوائر مغلقة من التصورات والمنظومات الذهنية التي يتعذّر
إختراقها وفحصها من الخارج، أو جعلها تحتكم إلى المنطلقات العامة المتمثلة
بالواقع والأصول العقلية المشتركة، وكل ما يمكن فعله هو الفحص المنطقي غير
المباشر (7)، وكذا الفحص الضمني لتبيان ما قد تفضي إليه من تعارضات ذاتية
أو ضمنية. ومن أمثلة الإعتبارات الذاتية المتعارضة في المنظومات المغلقة؛
ما جاء عن الفكر العرفاني حول العذاب وعلاقته بالأسماء. فهناك إعتبارات
حكمية وعرفانية متناقضة، فمن الإعتبارات الدالة على عدم الخلود في العذاب
ما ذكره صدر المتألهين في عدد من كتبه - كالشواهد الربوبية وغيرها - وهو أن
القسر لا يدوم في الطبيعة وأن لكل موجود غاية يصل إليها يوماً، كذلك أن
الرحمة الإلهية وسعت كل شيء. لكن في قبال هذه الإعتبارات هناك إعتبارات
أخرى منافية دالة على العذاب الدائم، كالقول بأن النفوس خاضعة للأسماء
الإلهية، وأن من الأسماء الإلهية ما يظهر بمظاهر الإنتقام والعذاب، وأن من
مقتضيات الأعيان الثابتة هو أن تكون على ما عليه بعد أن يفاض عليها الوجود،
فالسعيد من سعد في بطن أمه والشقي من شقي في بطن أمه. وكذا يمكن أن يقال
حول نظرية الفلاسفة في الصدور وما تتضمنه من تعارضات ضمنية (. وأيضاً هو
الحال مع ما جاء في نظام المتشرعة (المعياري) من إعتبارات تجريدية وضمنية
متعارضة، كالموقف من بعض قضايا الحسن والقبح وغيرها (9).
***
كانت
هذه نقاط ضعف الإتجاهات المعرفية للفكر المتحقق، بلا فرق بين تلك التي
عولت على الإعتبارات الذاتية أو العارضة. فالأولى انطلقت من مقولة (إنما
أُمرنا أن نأخذ العلم من فوق)، أي من النص (10). أما الثانية التي تشعبت
بها الطرق والإتجاهات فأغلبها تجريدية؛ إما بحكم موضوعاتها الخاصة، أو لأن
معالجتها للقضايا المعرفية كانت تحت سلطة العقل القبلي. وعليه فلو أردنا
إيجاد فكر متحقق جديد يتجنب الوقوع فيما وقع به الفكر المتحقق التقليدي؛
لكان لا بد من الأخذ بالنقاط التالية (11):
1ـ لا غنى عن المراجعة
النقدية المتواصلة للفكر الديني، أي مراجعة نقد الذات على التواصل. إذ لا
يمكن تحقيق تطور نوعي ملحوظ من غير هذا المبدأ، كالذي حصل مع العلم الحديث
في قطيعته مع القديم (12).
2ـ احضار الواقع بقوة ضمن مفاصل الفكر الديني، واحضار الدراسات التي تخص واقع الإنسان وحقوقه.
3ـ
تقليص الإعتبارات الذاتية مع توسعة الإعتبارات العارضة. وهذا ما يتطلب
العمل بجعل الأولى مجملة، على خلاف الثانية، سيما تلك التي تتعلق بالإنفتاح
على الواقع. والجمع بين هذين النوعين من الإعتبارات يتيح لنا أن نجعل من
الإعتبارات الذاتية موجهات دون أن يكون لها سلطة ذهنية تكوينية، خلافاً
للإعتبارات العارضة كما تتمثل بالواقع (13).
4ـ العمل على تفعيل
الإعتبارات العارضة المشتركة لا الخاصة. فقد جرّب الفكر المتحقق الديني
العمل وفق الإعتبارات الخاصة دون نجاح، وهو لم يجرّب بعد العمل وفق
الإعتبارات المشتركة. وحيث أن هناك نسقاً منطقياً يتحكم في العلاقة بين
المعرفة والوجود والقيم، لذا كانت المهمة الملقاة على عاتق الإعتبارات
المشتركة؛ الإنطلاق من البعد المعرفي ليتم بناء كل من النسقين الوجودي
والقيمي، وأخص بالذكر - هنا - ضرورة الارتكاز على منطق الإحتمال والإستقراء
في التكوين المعرفي.
* صراع المعيار والوجود في تمثيل الفكر الإسلامي:
يمكن
تقسيم علوم التراث ذات العلاقة بفهم النص والخطاب الديني إلى قسمين. فهناك
علوم تمهيدية متخصصة ومحايدة لا علاقة لها بشكل مباشر بفهم الخطاب، وإن
وظفت لهذا الغرض، كعلوم العربية والتاريخ والرجال والمنطق وما على شاكلتها.
وفي قبالها توجد علوم لها علاقة ماسة بهذا الفهم طبقاً لما تحمله من أدوات
معرفية وتأسيسات قبلية فرضت نفسها على آلية الفهم مباشرة، كعلم الكلام
والفقه والتفسير والحديث والتصوف والفلسفة...الخ.
ومع أن موضوعات
المجموعة الثانية من العلوم مختلفة، إذ لكل علم موضوعه الخاص، فما لعلم
الكلام هو غير ما لعلم الفقه من موضوع، وكذا الحال مع التفسير والحديث
والفلسفة والتصوف، فلكل من هذه العلوم معالجته الخاصة واستقلاليته النسبية،
لكنها مع ذلك تشترك في إخضاع الخطاب الديني للفهم. وعليه لو أنا اعتبرنا
الموضوع المشترك الجامع لهذه العلوم هو فهم الخطاب بالذات؛ لأصبحت بمثابة
علم واحد متعلق بهذا الفهم، ولكان من الممكن تقسيمها قسمة أخرى بحسب علم
الطريقة. إذ لا تشكل تلك الأجزاء والأقسام كتلاً مستقلة لكل منها موضوعها
المحدد، بل تقترب بعض الكتل من بعض، أو تندك بها لإتحاد طريقتها العامة في
الفهم.
فمن وجهة نظر «طريقية» تُصنف هذه العلوم ضمن كتلتين كبيرتين،
لكل منهما روحها الخاصة من النظر والتفكير، إلى الحد الذي تتضارب فيه
إحداهما مع الأخرى، وإن تداخلا على مستوى السطح والظهور التاريخي، كما يظهر
لدى المفكرين الذين حاولوا التوفيق أو التلفيق بينهما. فبحسب التحليل
الإبستمولوجي أن القطيعة والمنافاة بينهما ليست محايثة ولا تاريخية، بل
منطقية ذاتية جوانية، بغض النظر عن المجرى التاريخي لهما.
فكتلة
علوم الكلام والفقه وغالب تفسير القرآن والحديث؛ تتخذ إتجاهاً محدداً في
قبال كتلة الفلسفة والعرفان أو التصوف. فكل من الكتلتين يعبّر عن نظام
معرفي قائم في ذاته يتنافى جذراً وروحاً عن الآخر. ولا يعود السبب في هذا
التنافي المعرفي إلى إختلاف الموضوع الذي يعالجه النظامان من حيث الأساس.
فمع أن الفلسفة والعرفان تتعاملان مع موضوع «الوجود» قبل تعاملهما مع
الخطاب الديني، بخلاف الحال مع النظام الآخر، إلا أن هذا التمايز ليس هو
السبب في مصدر التضارب المنطقي بين النظامين، فمن المعلوم أن علوم النظام
الآخر تعالج أيضاً موضوعات جزئية مختلفة، ومع هذا فليس بينها منافاة من
النوع الذي أشرنا إليه. كما لا يمكننا أن نرجع السبب في مصدر التضارب
المعرفي للنظامين إلى الإختلاف في وجهات النظر بينهما هنا وهناك، إذ لا
يخلو أي نظام وجهاز معرفي من كثرة الخلاف، بما فيها الخلافات الكبيرة، ومع
ذلك لا يعني أن بينها قطيعة ومنافاة، على الصعيد المنطقي العام. يضاف إلى
أنه لا يسعنا إرجاع مصدر التضارب إلى إختلاف طريقة الاستدلال الصورية، إذ
هما كثيراً ما يشتركان في هذه الطريقة. يبقى أن نقول بأن مصدر التضارب يعود
إلى التباين الشاسع في الروح العامة لنمط التفكير لدى كل منهما، فطبيعة
المعرفة لكل منهما هي ليست من جنس الثانية، إلى الحد الذي يجعل من موضوع
البحث المشترك، وهو الخطاب الديني، يتمظهر بمظهرين لكل منهما الجنس المختلف
كلياً عن الجنس الآخر. ولنقل أن لكل منهما مرآته الخاصة المختلفة جذراً عن
الأخرى. لذلك لم تفض عمليات التوفيق بين الطبيعتين تاريخياً إلا إلى نوع
من التأسيس الجديد لصالح إحداهما على حساب الأخرى. فالتضاد بينهما هو تضاد
بين روح حتمية وأخرى غير حتمية، وليس من الممكن الجمع بينهما دون خسارة
إحداهما لحساب الثانية. وبالتالي فإن ذلك يدفعنا إلى القول بضرورة دراسة
هاتين الروحين كموضوعين في ذاتيهما بغض النظر عن العناصر الصورية المحايدة
التي توظفها كل منهما.
ومع أن من السهل أن تجد عالماً يجمع بين
الفلسفة والعرفان كما هو غالب الفلاسفة، أو يجمع بين الكلام والفقه كما هو
غالب المتكلمين، لكن يقل وجود من يجمع بين علوم الكتلة الأولى من جهة،
وعلوم الكتلة الثانية من جهة أخرى، سيما الجمع بين الفلسفة والفقه، كما هو
حال إبن رشد، وبأقل من ذلك من يجمع بين الفلسفة والكلام، كالذي يلاحظ لدى
الكندي، لكن الكندي عالم طبيعي ذو نزعة كلامية اعتزالية أكثر منه فيلسوف
محترف على شاكلة سائر الفلاسفة التقليديين؛ لكونه يتجاوز المبادئ الفلسفية
مثل موقفه من خلق العالم.
فعلاً أن هناك خروقات حصلت للكثير من
الفلاسفة والعرفاء عندما تناولوا القضايا الدينية، ومنها تلك التي عالجها
علم الكلام. فمثلاً أن لإبن رشد رأياً حول القضاء والقدر يخالف مبناه
الفلسفي. فهو يتوسط في حل المشكلة ويرى أن إرادتنا للأشياء لا تتم إلا
بمؤاتاة الأسباب الخارجية والداخلية - في أبداننا - التي سخّرها الله
تعالى، والتي منها ما يكون حافزاً على الفعل أو مثبطاً له. بهذا تجري
الأفعال على نظام محدود مقيّد بالأسباب والإرادة معاً، حيث كلاهما يشكل
الحد العام للقضاء والقدر الذي كتبه الله تعالى على عباده (14). لكن مع ذلك
فهذه الرؤية تخالف مبنى إبن رشد الفلسفي وحتمية نظام الضرورة في الأسباب
والمسببات في الوجود كله من أوله حتى آخره (15).
كما أن لصدر
المتألهين آراءاً حول خلق السماوات والأرض تتعارض مع مبانيه الفلسفية. ومن
ذلك جمعه بين الإعتبارات الفلسفية القائلة بضرورة أزلية الفيض وأبديته
وإستحالة عدم الكائنات أو خلقها من العدم تبعاً لمنطق السنخية، وبين
الإعتبارات الدينية التي تقر بأن الله قادر على أن يخلق السماوات والأرض في
لحظة واحدة (16)، كما وله القدرة على إفنائهما متى شاء في أي لحظة (17)،
وأن الدنيا ستفنى بقيام الساعة الكبرى. كذلك إعتقد تبعاً للمنطق الفلسفي
أنه لا بد للعقول المجردة أن تظل ثابتة لا تتعرض للتغير والتحول بإعتبارها
ليست من جملة العالم ومما سوى الله، بل باقية ببقائه وموجودة بوجوده من دون
جعل وتأثير (18). لكنه مع ذلك أقر بفناء العقول ورقيها بالتحول إلى ما هو
أعلى منها شأناً، تلفيقاً مع بعض النصوص الدينية التي صرحت بموت وفناء الكل
(19).
وبالتالي فما نود قوله هو أن واقع الفلاسفة والعرفاء
والمتكلمين وحتى الفقهاء؛ لا يعكس بالضرورة الإتساق مع المبادئ الفلسفية
والعرفانية والكلامية والفقهية الملتزم بها دائماً، سيما الأصول المولدة
وتفريعاتها.
***
من المعلوم قبل كل شيء أن لنظام الفلسفة
والتصوف وجوداً مستقلاً سبق وجود الخطاب الديني أو الإسلامي لمدة تناهز
عشرة قرون خلت. وكانت إشكاليته المعرفية هي إشكالية «وجودية» تتخذ من
«الوجود العام» موضوعاً لها، مضفية عليه الطابع الحتمي في جميع مراتبه
ومفاصله. لذا آثرنا تسميته بـ (النظام الوجودي) الحتمي، فما قدّمه من تنظير
يمتاز بالطابعين الوجودي والحتمي معاً، حتى على مستوى تعامله مع الخطاب
والقضايا المعيارية، كما فصلنا ذلك في (الفلسفة والعرفان والإشكاليات
الدينية).
أما علوم النظام الآخر فقد نشأت بعد وجود الخطاب الديني،
وقد علقت بهذا الخطاب بشتى الأشكال والنواحي، لذلك لم يكن هناك مانع يفصلها
عن فهمه مثلما هو الحال مع النظام الوجودي. فموضوعها الأساس إن لم يكن عين
النص أو الخطاب ذاته، فهو لا يخرج عن القضايا التي تتعلق به مباشرة هنا
وهناك. وعليه فمن حيث ذاتها أنها ليست مستقلة، ولا كان بالإمكان معالجتها
وقراءتها بمعزل عن العلاقة بالنص أو الخطاب، خلافاً لما هو الحال مع النظام
الوجودي، لكونه مستقلاً بذاته، وبالتالي فمن الناحية المنطقية جازت
معالجته لذاته وبغض النظر عن علاقته بالنص. وهو ما اضطرنا إلى المغايرة في
الطرح بين القراءتين المخصصتين لهذين النظامين، إذ سنفرد للنظام الوجودي
باباً من المعالجة قبل احتكاكه بالنص وعلاقته بفهمه، لنتعرّف عليه كشيء
مستقل في ذاته وبغض النظر عما قدّمه من طريقة فهم. ولم نفعل الشيء ذاته مع
النظام الآخر لإلتصاقه بالفهم كما أشرنا.
لكن لما كانت علوم النظام
الآخر غير مستقلة في ذاتها عن الخطاب، فهي إما مبنية على فهمه أو على
الموضوعات العالقة بأجواءه، وحيث أن للخطاب طبيعة معيارية تتضمن «الروح
الانشائية» وتتخذ من نظرية التكليف قطبها الأساس، لذا فقد اصطبغت هذه
العلوم بالصبغة المعيارية، أي أنها تنتمي إلى ما نطلق عليه «النظام
المعياري»، دون أن يعني ذلك بأن الخطاب هو الآخر ينتمي إلى هذا النظام،
بإعتباره مادة خام بالقياس إلى الأنظمة والأجهزة التي تطرح نفسها لفهمه
ومعالجة قضاياه.
ومصطلح (المعياري) جاء ليقابل مصطلح الوصفي
والتقريري للأشياء الخارجية، فمعناه هو ما ينبغي عليه الشيء أن يكون. وفي
بعض المعاجم الفلسفية عُرّف (المعيار) لدى المنطقيين بأنه نموذج مشخص لما
ينبغي أن يكون عليه الشيء، وهو النموذج المثالي الذي تنسب إليه أحكام
القيم، فالمعيار في الأخلاق هو النموذج المثالي الذي تقاس به معاني الخير،
والمعيار في المنطق هو قاعدة الإستنتاج الصحيح، وفي نظرية القيم هو مقياس
الحكم على قيم الأشياء. والعلوم المعيارية هي عند (ووندت) عبارة عن العلوم
التي تهدف إلى صوغ القواعد والنماذج الضرورية لتحديد القيم، كالمنطق
والأخلاق وعلم الجمال. وتقابل هذه العلوم نظيرتها المسماة بالعلوم
التفسيرية أو التقريرية القائمة على ملاحظة الأشياء وتفسيرها، كما في علوم
الطبيعة، فهي علوم خبرية خلافاً للعلوم المعيارية التي يمكن تسميتها
بالعلوم الإنشائية (20). وبالتالي فما نعنيه بالنظام المعياري لدى الفكر
الإسلامي هو التفكير في مجال القيم بما ينبغي عليه الشيء أن يكون.
لذا
فمن حيث الدقة، أن الفارق بين النظرتين الوجودية والمعيارية هو أن النظرة
الوجودية ترى الأشياء من حيث ذواتها وصفاتها وعلاقاتها الكينونية. في حين
تترصد النظرة المعيارية البحث في الفعل الإرادي ودوافعه النفسية وما ينطوي
عليه أو يقتضيه من صفات وعلاقات انشائية أخلاقية لا كينونية. فشرط الوجود
هو الذات، وبالأساس الذات الإلهية، فمن خلالها تتشخص طبيعة النظرة إلى سائر
الوجودات. بينما شرط «المعيار» هو القدرة والإرادة، فبها يمكن الحديث عن
الخصال المعيارية للفعل أو السلوك الحر. وبالتالي فلولا الذات ما كان
للوجود وجود، كذلك فلولا القدرة والإرادة ما كان للمعيار عيار. وبهذا
التمايز بين النظرتين (الوجودية والمعيارية) يمكننا أن نتفهم طبيعة التفكير
لدى كل منهما.
فميزة النظام الوجودي عن النظام المعياري هو أن
الأول لا يشرّع إلا بأخذ إعتبار «الوجود» ولأجله. فحتى القضايا المعيارية
تكون محددة ومقاسة طبقاً لـ «الوجود». بينما ينعكس الحال في النظام
المعياري، سواء في دائرته العقلية أم البيانية. إذ يقوم التشريع فيه على
«المعيار» ولأجله؛ بما في ذلك تحديد قضايا الوجود وإعتباراته. فبحث الدائرة
البيانية حول (المشكل الوجودي) كما يتمثل بالصفات الإلهية لا يخرجها عن
الطبيعة المعيارية، فهي تعالج هذا المشكل إعتماداً على بيان النص وتبعاً
للدوافع اللاهوتية. أما الدائرة العقلية فمن الواضح أن محور إهتمامها يتمثل
بالعلاقة التكليفية التي تربط المكلِّف بالمكلَّف، وهي حتى في تعاملها مع
القضايا الوجودية، كبحثها في الأمور الفيزيقية والميتافيزيقية، تنطلق في
الغالب من الدافع اللاهوتي. ويصدق هذا الأمر على الإتجاهات التي انقسمت على
نفسها بين عدد من الدوائر، كمذهب الأشاعرة المتقدمين، فهو في تحديده
لقضايا الصفات كمشكل وجودي يتبع المنهج البياني بخلفياته اللاهوتية، أما
بالنسبة لقضايا العلاقة التكليفية فإنه يتبع المنهج العقلي. أي أنه منقسم
على ذاته بين الدائرتين ومتمشكل بكلا المشكلتين (الوجودية والمعيارية).
فالغرض
من الإهتمام الغالب بعلوم الكلام والفقه وتفسير القرآن والحديث وما على
شاكلتها هو لتحديد العلاقة المعيارية لنظرية التكليف، فهي قطب الرحى الذي
تدور حوله هذه العلوم. فليس هناك موضوع في ذاته ولأجله تقوم عليه تلك
العلوم أشد وأقوى من هذه النظرية بما تنطوي عليه من تحديد لعلاقات الحق بين
المكلِّف والمكلَّف. فمن حيث الأساس أن نصوص الخطاب الديني دالة على
التكليف، بل هي عين التكليف ذاته، وهو ما جعل تلك العلوم التي قنّنت هذه
النصوص تتجه هي الأخرى بإتجاه هذه القضية المركزية. فدائرة البحوث الفقهية
هي عينها دائرة علم التكليف، فقد شهد الفقه تضخماً في البحث والتقنين خلال
القرون الأولى، وامتص من الطاقات الفكرية ما يكفي أن نعرف أنه منذ القرن
الأول حتى القرن الرابع الهجري ظهرت إتجاهات كثيرة من المدارس الفقهية؛
قدّرها البعض بما لا يقل عن تسع عشرة مدرسة (21)، كل ذلك لغرض تحديد دوائر
التكليف طولاً وعرضاً. ومع أن الإجتهاد الفقهي تكفّل بتحديد دوائر التكليف
لإبتلاء طاعة المسلمين في شؤون ممارساتهم العملية؛ إلا أنه هو الآخر كان
خاضعاً لذات التكليف. وكما قرر الشافعي بأن الله قد ابتلى طاعة المسلمين
«في الإجتهاد كما ابتلى طاعتهم في غيره مما فرض عليهم» (22).
كذلك
الحال مع علم الكلام، فقد لجأ هو الآخر إلى تحديد التكليف مباشرة بما هو
«موضوع في ذاته»، فهناك مباحث عامة عن التكليف وشروطه وعلاقته بالعدل
وإرادة الإنسان، كما أن مقدمات كتب هذا العلم قد ألِفت أن تشرع بالبحث عن
وجوب العلم، وعما يجب على الإنسان أن يعرفه أولاً، وعن تحديد عقيدة الفرقة
الناجية وسط فرق الضلال. فأصبح التكليف مقدمة للكلام، بل أصبح الكلام
تكليفاً، فبنظر أصحاب الكلام تعتبر قضايا هذا العلم الأساسية من التكاليف
الواجب على المسلم بحثها عيناً لتحديد عقيدته سلفاً. فمثلاً ذكر الباقلاني
في كتابه (الإنصاف) ما يجب إعتقاده ولا يجوز الجهل به، فعدّد مختلف قضايا
الكلام الأشعرية، وأضاف إليها العلم بأوائل المعرفة وأصول الأدلة والمقصود
بالاستدلال وإنقسام المعلومات والموجودات والمحدثات، كما أوجب على المكلَّف
معرفة أول نعم الله على خلقه وأفضلها عند المؤمنين المطيعين وغيرها من
القضايا الأخرى (23). ومعلوم أن الباقلاني أذاع مبدأ (بطلان الدليل يؤذن
ببطلان المدلول) خلال القرن الرابع الهجري، لذلك فقد زاد من حمولة التكليف
فشملت قضاياه حتى الأدلة المحررة، إذ خرجت من كونها في دائرة ما هو «موضوع
لأجله» لتدخل دائرة ما هو «موضوع في ذاته» من التكليف، الشيء الذي يعني أن
الكلام قد أصبح «شريعة»، والإجتهاد «نصاً». فلما كان الاستدلال على بعض
العقائد، كالقدرة والخلق، متوقفاً عند الباقلاني على إثبات الخلاء والجوهر
الفرد والعرض لا يبقى زمانين وغيرها (24)، لذا فقد اعتبر هذه القضايا ضمن
العقائد الواجب إعتقادها، وبالتالي فهي قضايا وجودية مؤسسة على المعيار،
خلافاً لطريقة الوجوديين، لكونهم يؤسسون المعيار على الوجود لا العكس.
بل
لدى المعياريين أن مبرر وجود الخلق هو لغرض معياري يتعلق بالتكليف، إذ
سُخّرت الأشياء للإنسان ليعتبر منها ويتخذها مرشداً ودليلاً على التكليف،
بما في ذلك التكاليف العقلية، كما يلاحظ - مثلاً - لدى الذين اعتبروا الغرض
من وجود الشهوات في الإنسان إنما لأجل التكليف (25)، طبقاً لإعتبار
المقدمات والنتيجة التالية:
1ـ إن طبع الناس يميل إلى فعل القبيح بسبب وجود الشهوات.
2ـ لو ترك الناس من غير تكليف لفعلوا القبيح.
3ـ إن ترك الناس على هذا الحال يعني إغراءً لهم على فعل القبيح.
4ـ إن هذا الإغراء على فعل القبيح هو عبث وقبيح.
5ـ ومن ثم فإن العبث والقبيح لا يجوزان على المولى تعالى.
6ـ وحيث أنه إذا كان هناك غرض في فعله تعالى؛ فلا يحصل هذا الغرض إلا بالتكليف، وهو المطلوب إثباته (26).
كما
ذهب الحر العاملي إلى أن الحكمة من خلق الشهوات والشياطين وغيرها تتمثل
بالتكليف والتعريض لزيادة الثواب، وكذا هو الحال مع نصب الشبهات وانزال
المتشابهات (27).
كان ذلك مما له دلالة على البحث الكلامي بما هو
«موضوع في ذاته» من التكليف. أما البحث الكلامي بما هو «موضوع لأجله» فإنه
يستغرق ما تبقى من مواد علم الكلام، ويتوارى في كثير من الأحيان وراء
الأدلة المحررة، بما في ذلك أدلة إثبات أصول العقائد كالتوحيد والعدل، فرغم
تضاربها بحسب الميول المذهبية إلا أنها تهدف إلى التنزيه والتقديس بعيداً
عن شبهة التدنيس ومخالفة الشريعة، بغية ضمان «الإعتقاد الحق»، لذلك لا يخلو
لسانها من التعريض بكل من يخالف هذا الحق، بالتكفير والتضليل، مما له
دلالة على «التكليف» بوصفه معياراً يتوارى خلف لغة الكلام وعلمه.
يضاف
إلى أن نشأة علم الكلام ومجادلات «الصخب» التي ظهرت في أوساطه، لم تتجاوز ـ
هي الأخرى ـ حدود ذلك المعيار. فقد نشأ الإعتزال على يد (واصل بن عطاء)
بعد اعلان رأيه حول «منزلة الفاسق» (28)، بل أن أغلب أصول المعتزلة الخمسة
لها دلالة معيارية على التكليف. كما أن الأشاعرة هي الأخرى لم تستقل عن
المعتزلة ولم تنفصل عنها إلا بعد إحساسها بما ضيعته من «واجب التكليف»،
وذلك بعد المناقشات التي دارت بين الأشعري واستاذه الجبائي حول قضايا لها
علاقة صميمة بنظرية التكليف، كقضية الصلاح والأصلح.
ويلاحظ أن
الممارسة العقلية لعلم الكلام تقف على الضد والتنافي مع الممارسة العقلية
للفلسفة التقليدية. فالنظام الذي ينتمي إليه كل منهما هو على الضد من
الآخر. فبحسب الفهم الطريقي أن العقل الكلامي هو عقل معياري خلافاً لما
يتصف به العقل الفلسفي من صفة وجودية غير معيارية. وبالتالي فإن الروح
المعرفية وطريقة التفكير ونوع النتائج لكل منهما هي مختلفة تماماً.
وعموماً
يمكن القول بأن منهج علم الكلام هو أقرب للتفكير الديني، أو أنه ممزوج
بهذا التفكير، وأن أتباعه يحملون عقيدة آيديولوجية مذهبية دينية، وعلى
خلافه منهج الفلسفة المتحرر غالباً من هذه المذهبية، وأنه أقرب للمنهج
العلمي، سيما وأن العلوم الطبيعية كانت في ذلك الوقت تُبحث وتُدرس ضمن
الفلسفة، وأن العلماء كانوا إما فلاسفة أو دائرين في فلكهم. لذلك فالتطور
العلمي الذي حصل خلال تاريخ الإسلام إنما كان بفعل الفلسفة لا الكلام، رغم
بعض مؤاخذاتنا على علاقتها بعلوم الطبيعة، كما سجلناها في كتاب (مدخل إلى
فهم الإسلام). لذا ففي فهم القضايا الدينية يسهل الإنفكاك تماماً من
الفلسفة، لكن من الصعب الإنفكاك من علم الكلام وتفكيره الديني؛ بإعتباره
مختصاً في أسس وأركان هذه القضايا خلافاً للأولى.
وحقيقة، لولا أن
الفلسفة ومعها العرفان قد تعرضا للخطاب الديني بالفهم والتبعية كمنهج؛
لكُنّا قد اعتبرناهما يقعان عرضاً وموازاة في منافسة منطق الدين ذاته. فهما
ينافسان هذا المنطق ومدعياته الأساسية. لذا يصعب عليهما تبرير أصول
المسألة الدينية وأركانها الأربعة، خلافاً لعلم الكلام.
لا يقال بأن
للفلسفة التقليدية المنهج البرهاني، إذ لا تسلّم بشيء ما لم تقم الدليل
عليه، خلافاً للكلام. ذلك أن كلاً منهما يقيم المنهج الاستدلالي طبقاً
للمسلمات الخاصة به، مثلما أشار إلى ذلك إبن رشد (29). بل يمكن القول أن
الفلسفة التقليدية ليست برهانية بإطلاق، بل أنها مقيدة ضمن ما تفترضه من
ماهيات كلية في الذهن، فهي بالتالي ليست برهانية من حيث علاقتها بالواقع أو
انطباقها معه. ويمكن تصوير هذه الناحية بمثال يعود إلى الهندسة الكونية،
فحينما نقول أن مجموع زوايا المثلث هو (180 درجة)، فهذا القول صحيح قياساً
إلى ما نحمله من تصور وإفتراض ذهني، لكنه ليس معنياً بالواقع الموضوعي
فعلاً. فنحن نتعامل مع سطح مستو على الصعيد الذهني، في حين ليس بالضرورة أن
يكون مبنى الواقع بمثل هذا السطح، وبالتالي قد لا يكون مجموع تلك الزوايا
بالقدر المذكور. فمثلاً أن نظرية اينشتاين في النسبية العامة قد عوّلت على
السطح المنحني للهندسة الكونية، وأخذت تصور الواقع بأنه أشبه بقطعة
البطاطس، لهذا كان مجموع زوايا المثلث حسب هذا الإفتراض مغايراً للدرجة
السابقة، خلافاً لنظرية نيوتن في تصورها لتلك الهندسة (30). وهكذا الحال
يمكن قوله حول ما يتعلق بالفلسفة التقليدية.
ويترتب على ذلك أن
الفلسفة والكلام لم يتعاملا تعاملاً محايداً إزاء القضايا التي اعترضتهما،
سيما القضايا الرئيسة للعقيدة الدينية. ومع ذلك فإن لكل منهما إجتهاداته
الخاصة، إلى الدرجة التي يتفقان فيها غالباً على ترجيح الرؤية العقلية على
النص، إذ يعتبرانها قاطعة خلافاً للأخير، لكنهما يختلفان في مضامين تلك
الرؤية تماماً.
كما لعبت اللغة دوراً هاماً وعظيماً، لا فقط في حدود
ما هو «موضوع لأجله» بما تمده من مقدمات لتحديد فهم موارد الأمر والنهي من
التكليف، بل كذلك أنها في مرحلة التقنين قد عبّرت أحياناً عن علم ما هو
«موضوع في ذاته» من أبعاد الفقه والتكليف، فهي الدين بعينه على حد تعبير
أبي عمرو بن العلاء (31)، وكما ينقل البعض قول الجرمي الفقيه بأنه منذ
ثلاثين سنة كان يفتي الناس في مسائل الفقه من كتب سيبويه في النحو (32).
وربما كان القصد من ذلك أنه لا يتجاوز توظيف طريقة سيبويه في النحو كـ
«موضوع لأجله» لا «موضوع في ذاته» من الفقه.
وهكذا هو الحال مع علوم
أخرى كتفسير القرآن والحديث والسيرة وما إليها. فمثلاً رأى جماعة من
العلماء بأن علة وجود المحكم والمتشابه في القرآن هو لغرض تكليفي، إذ كُلّف
الإنسان بالإجتهاد في النظر لمعرفة ما هو محكم وما هو متشابه. وقد ذكر
القاضي عبد الجبار الهمداني في جواب على سؤال عن وجه الحكمة في وجود المحكم
والمتشابه في القرآن فقال: «إنا إذا علمنا عدل الله وحكمته بالدلالة
القاطعة التي لا تحتمل (الخلاف)، نعلم أنه لا يفعل ما يفعله إلا وله وجه من
الحكمة في أفعاله تعالى. وقد ذكر أصحابنا في ذلك وجوهاً لا مزيد عليها.
أحد الوجوه: أنه تعالى لما كلفنا النظر وحثنا عليه ونهانا عن التقليد
ومنعنا منه، جعل القرآن بعضه محكماً وبعضه متشابهاً، ليكون ذلك داعياً إلى
البحث والنظر وصارفاً عن الجهل والتقليد. والثاني أنه جعل القرآن على هذا
الوجه ليكون تكليفنا به أشق، ويكون في باب الثواب أدخل، وذلك شائع. فإن
القديم تعالى إذا كان غرضه بالتكليف أن يعرضنا إلى درجة لا تنال إلا
بالتكليف، فكل ما كان أدخل في معناه كان أحسن لا محالة» (33). وعلى هذه
الشاكلة ذكر الزركشي بأن الله جعل كتابه محكماً ومتشابهاً ليحثهم على
التفكير فيه ومن ثم يثيبهم على قدراتهم وجهودهم الإجتهادية (34).
وهناك
من المعياريين من جعل العلوم كلها موضوعة لنظرية التكليف، كابن حزم
الاندلسي، إذ ذكر بأن الغرض من وجودنا في الدنيا هو تعلم ما أراده الله
تعالى منا وأخبرنا عنه، وهو معرفة الشريعة والعمل بموجبها للتخلص من البلاء
الذي ابتلانا الله تعالى به في الدنيا. فقد ربط إبن حزم العلوم بهذه
الغاية المعيارية. وعلى رأيه أنه لا تتم صحة معرفة الشريعة إلا بمعرفة
أحكام الله وعهوده في كتابه المنزل، وكذلك بمعرفة ما بلّغه النبي (ص) إلينا
وما أوصانا به، وأيضاً ما أجمع علماء الديانة عليه وما اختلفوا فيه، وكل
ذلك لا يتم إلا بمعرفة الرجال الناقلين لتلك الأمور وأزمانهم وأسمائهم
وأنسابهم، ومعرفة المقبولين منهم وتفرقتهم عن غيرهم. كما أن ذلك لا يتم إلا
بمعرفة القراءات المشهورة ليوقف بذلك على المعاني المتفق عليها وتمييزها
عن غيرها، وهو لا يتم إلا بمعرفة اللغة ومواقع الإعراب وما يقتضيها من
التعرف على علم الشعر لعلاقة الإعراب به. كما لا بد من التعرف على علم
الهيئة لمعرفة القبلة وأوقات الصلوات، ولا بد من معرفة علم الحساب لتقسيم
المواريث والغنائم وغيرها. كما لا بد من التعرف على حدود الكلام لمعرفة
حقيقة البرهان مما يحتاج إلى علم المنطق والفلسفة. ولا بد أيضاً من معرفة
العيوب التي تجبّ التكليف كعاهة الجنون والآفات المختلفة، وهو ما يحتاج إلى
علم الطب. ولا بد لمعرفة كيفية الدعاء إلى الله من علم الخط والبلاغة وما
إليها. كما أنه لا بد من معرفة عبارات الرؤيا بإعتبارها حقاً «وهي جزء من
ستة وأربعين جزءاً من النبوة»، وهو ما يحتاج إلى التمكن من سائر العلوم
المذكورة. وأخيراً يذكر إبن حزم بأن الحاجة تمت إلى التعرف على علم النجوم
لمعرفة الصواب من الخطأ في القضاء بالنجوم. وبذلك تكون جميع العلوم التي
عرفها هذا المفكر لها غاية معيارية تتمثل في نظرية التكليف (35).
ويلاحظ
أن هناك خصوصيتين للبنية المعيارية داخل النظام المعياري، إحداهما معرفية،
وهي التي تناظر ما عليه النظام الوجودي. أما الأخرى فليس لها ما يقابلها
في النظام الأخير، إذ تتضمن جانباً من الموقف النفسي إتجاه القضايا الدينية
والإحساس بالقداسة، كما يتم التعبير عنها بالحرمة إزاء «معيار» نظرية
التكليف، خشية التفريط بالحق المتعلق بالله أو المكلِّف. فالكثير من علماء
هذا النظام يتحرّجون من أن يضيفوا رأياً من عندهم خارج الحد المتعارف عليه،
خشية تجاوز هذا الحق المعياري؛ بما في ذلك «المسائل الوجودية» التي نصّ
عليها الخطاب، كمسألة ال إستواء على العرش، الأمر الذي يفسّر السبب الذي
جعل أغلب علماء السلف يلجأون إلى التفويض والاحتياط خلال القرون الثلاثة
الأولى للهجرة. وكثيراً ما كان العالم يتخذ من قاعدة الاحتياط موقفاً
عملياً، حتى لو كان رأيه النظري بخلاف ما يؤدي إليه الموقف العملي وما
يستلزمه هذا الموقف من حدوث بعض الأضرار (36). ويذكرنا هذا الأمر بما نقله
الشيخ محمد جواد مغنية عن أحد أساتذته أثناء الدرس حول طهارة أهل الكتاب،
حيث قال الأستاذ: «إن أهل الكتاب طاهرون علمياً نجسون عملياً»، فأجابه
الشيخ بالحرف أيضاً: «هذا إعتراف صريح بأن الحكم بالنجاسة عمل بلا علم».
مما جعل الاستاذ ورفاق الصف يضحكون، كما نقل (37).
ورغم توظيف
النظام المعياري لعلوم العربية لصالحه، سيما ما يتعلق بالدائرة النقلية،
لكن ذلك لا يجعل من هذه العلوم علوماً تابعة له، فهي محايدة كالمنطق في
علاقته بالفلسفة، وإن تمّ توظيف كل منهما لتحقيق مطالب النظامين، بل أن
الشواهد التاريخية تثبت بأن التوظيف كان في بعض الأحيان معكوساً، بمعنى أن
النظام المعياري وظّف المنطق لصالح قضاياه ضد النظام الوجودي، كما أن
الأخير وظّف بدوره اللغة العربية لإثبات مطالبه ضد الأول. وهذا يعني أن
كلاً من اللغة العربية والمنطق لا يحمل تصورات عقائدية أو وجودية خاصة، بل
هما صوريان يقبلان التطبيق على مختلف العلوم التي تناسبهما.
لذلك
فإن مناقضة البيانيين للمنطق ليس المقصود منه مناقضته لذاته، فهو في حد
ذاته لا يعارض البيان أو المعيار؛ بإعتباره صورياً، بل لأن الفلاسفة صاغوه
واستخدموه لأغراضهم «الوجودية» حتى أصبح ملاصقاً لأعمالهم الفلسفية، لذا
أبعده أهل المعيار عن إهتمامهم وحرّمه آخرون لهذا الغرض، حتى حان وقت إعادة
ترتيب إعتباره وتوظيفه داخل حيز البيان والنظام المعياري عموماً، كما فعل
إبن حزم والغزالي والفخر الرازي وغيرهم، وهو ما أشار إليه إبن خلدون في
مقدمته. فكما ذكر بأن «صناعة المنطق قبل إمام الحرمين الجويني لم تكن ظاهرة
في الملة، وما ظهر منها بعض الشيء لم يأخذ به المتكلمون لملابستها للعلوم
الفلسفية المباينة للعقائد الشرعية بالجملة، فكانت مهجورة عندهم لذلك»
(38). ونقل السيوطي في (الحاوي للفتاوي) آراء عدد من العلماء الذين حرموا
الاشتغال بالمنطق لكونه، كما يعتقد، يجر إلى الفلسفة والزندقة، فاعتبر أول
من نصّ على التحريم الشافعي، ومن أصحابه إمام الحرمين والغزالي في آخر
أمره، وإبن الصباغ صاحب (الشامل) وإبن القشيري ونصر المقدسي والعماد بن
يونس وحفده والسلفي وإبن بندار وإبن عساكر وإبن الأثير وإبن الصلاح وإبن
عبد السلام وأبو شامة والنووي وإبن دقيق العيد والبرهان الجعبري وأبو حيان
والشرف الدمياطي والذهبي والطيبي والملوي والأسنوي والأذرعي والولي العراقي
والشرف بن المقري وقاضي القضاة شرف الدين المناوي. ونصّ عليه من أئمة
المالكية إبن أبي زيد صاحب (الرسالة) والقاضي أبو بكر بن العربي وأبو بكر
الطرطوشي وأبو الوليد الباجي وأبو طالب المكي صاحب (قوت القلوب) وأبو الحسن
بن الحصار وأبو عامر بن الربيع وأبو الحسن بن حبيب وأبو حبيب المالقي وإبن
المنير وإبن رشد وإبن أبي جمرة وعامة أهل المغرب. ونصّ عليه من أئمة
الحنفية أبو سعيد السيرافي والسراج القزويني الذي ألّف في ذمّه كتاباً سماه
(نصيحة المسلم المشفق لمن ابتلى بحب علم المنطق). كما نصّ عليه من أئمة
الحنابلة إبن الجوزي وسعد الدين الحارثي وإبن تيمية الذي ألّف في ذمّه ونقض
قواعده مجلداً كبيراً سماه (نصيحة ذوي الإيمان في الرد على منطق اليونان)
(39).
لكن على رأي إبن خلدون فإنه منذ الجويني أخذت صناعة المنطق
طريقها وسط أهل الملة، ثم انتشرت وقرأها الناس وفرّقوها عن العلوم الفلسفية
من حيث أنها قانون ومعيار للأدلة فقط (40). ثم جاء الفخر الرازي فسبق غيره
في إعتبار المنطق علماً مستقلاً بذاته؛ وهو أنه آلة للعلوم (41).
أما
نظام الفلسفة والتصوف فحيث أنه يستند إلى إشكالية الوجود والحتمية، فإن
فهمه للخطاب لم يرتكز على نزعة «المعيار» كما هو الحال في النظام الأول، بل
قام على نزعة «الوجود» وإعتباراته الحتمية، إلى الحد الذي أصبح الخطاب
بحسب هذا الفهم مرآة لإظهار الوجود وحتميته حتى في القضايا المعيارية
الصميمة؛ بما فيها مسألة التكليف ذاتها. فطبقاً لهذا الفهم فإن عملية
التكليف التي يبديها الخطاب تتخذ طابعاً مجازياً حقيقته الوجود والحتمية.
وكتأكيد
على هذا المعنى نرى الفيلسوف الأرسطي إبن رشد يردّ مصدر التكليف الأمري
الإنشائي (المعياري) إلى تكليف (وجودي)، إذ اعتقد بأن لله أمراً «وجودياً»
حكم فيه على الفلك الذي يخصّه بالحركة وأمر سائر المبادئ المفارقة بأن تأمر
جميع الأفلاك الأخرى بالحركات، وهو الأمر الذي قامت عليه السماوات والأرض
«وهذا التكليف والطاعة هي الأصل في التكليف والطاعة التي وجبت على الإنسان
لكونه حيواناً ناطقاً» (42). وهو من منطلق هذا المعنى جعل عبادة الحكماء
وشريعتهم الخاصة «وجودية»، وذلك لأن خصوصية هذه العبادة والشريعة تتعلق -
عنده - بالفحص عن جميع الموجودات «إذ كان الخالق لا يُعبد بعبادة أشرف من
معرفة مصنوعاته التي تؤدي إلى معرفة ذاته سبحانه على الحقيقة، الذي هو أشرف
الأعمال عنده وأحظاها لديه» (43).
كما أن صدر المتألهين اعتبر
الرسالات السماوية للأنبياء داخلة في المعنى الوجودي الحتمي، متصوراً أن
فائدتها الوجودية جاءت تبعاً لما يفرضه القضاء الوجودي في سابق الأزل (44).
وهو من منطلق هذا المعنى فَهِمَ قضايا الخطاب المعيارية فهماً وجودياً
خالصاً، كما في تفسيره لآية ((قل كل يعمل على شاكلت
المتعلق بهما. فالنص الديني هو العنصر المؤسس لكل من التراث والفكر
الإسلامي. والتراث المعرفي هو كل ما وصلنا من هذا الفكر. لكن الأخير أعم من
التراث لزيادته عليه بالفكر الإسلامي المعاصر، وكلما صار الأخير تراثاً
كلما زاد عليه الفكر الإسلامي بفكر معاصر آخر، وهكذا يظل الفكر الإسلامي
قابلاً للتحديث والتجديد، وهو ما لا يصدق على التراث بإعتباره أمراً قاراً
مقارنة بعموم الفكر.
وهنا نتساءل: ما هي خصوصية الفكر الإسلامي؟ أو ما الذي يميزه عن غيره من ضروب التفكير؟
قبل الإجابة على هذا السؤال لا بد من أن نعرف بأن خصوصية أي فكر تعتمد
على ما يستند إليه هذا الفكر من مصادر معرفية منضبطة. وهي على نوعين
متلازمين لا غنى لأي فكر أو علم من أن يرجع اليهما للإنتاج والتوليد
المعرفي، كما يلي:
1ـ مصادر ذاتية: وهي تشكل خصوصية الفكر المعني،
وبدونها ينتفي ذلك الفكر. وتمتاز بأنها تحمل «إعتبارات معرفية» خاصة (غير
مشتركة) لدى تيارات الفكر المختلفة.
2ـ مصادر عارضة: وهي ليست
ذاتية، أو ليس لها خصوصية الفكر المعني، لكنها قد تلعب دوراً أعظم من
المصادر الذاتية نفسها. وتمتاز بأنها تحمل «إعتبارات معرفية» قد تكون
مشتركة أو خاصة.
والمقصود بالإعتبارات – كما وردت في النوعين
السابقين للمصادر - ليس المفهوم الضيق الذي استخدمه الفلاسفة المسلمون،
حينما قالوا: لولا الإعتبارات لبطلت الحكمة أو الفلسفة (1)، وكانوا يقصدون
بها تلك الإعتبارات العدمية كما وظفت لأجل تبرير نظرية الفيض والصدور. إنما
المقصود بها الدواعي والأدلة التي تتولّد عنها النتائج المعرفية. ولهذه
الدواعي والأدلة طبائع مختلفة، إذ قد تكون الطبائع دينية، أو علمية؛
كإعتبارات مبدأ البساطة والتجريب، وقد تكون وجودية كإعتبارات مبدأ السنخية
(أي علاقة الأصل والشبه). فالاستدلال على صدور الواحد عن مبدأ الوجود الأول
- مثلاً - مستمد من منطق السنخية، ومثله القول بكون العالي يحمل صفات
السافل على نحو أكمل، وتنطبق هذه الإعتبارات على الإعتقاد بازلية الصنع
ونفي البداية المحددة لخلق العالم، ومثل إعتبار الفلاسفة بأن كل مجرد يعقل
ذاته وغيره؛ إستناداً إلى كونه فعلي الوجود من دون حجاب المادة المانعة
(2). فجميع هذه الإعتقادات مستندة إلى إعتبارات خاصة تتعلق بمنطق السنخية
لدى الفلاسفة.
لكن قد تحمل الإعتبارات دواعي وأدلة مشتركة، بمعنى أنها موضع ثقة جميع الدوائر المعرفية. ويمكن تحديد الإعتبارات المشتركة بكل من:
1ـ إعتبارات حقائق الواقع الموضوعي.
2ـ الإعتبارات الرياضية الثابتة.
3ـ الإعتبارات المنطقية الواضحة كمبدأ عدم التناقض.
4ـ الإعتبارات العقلية المشتركة كمبدأ السببية.
5ـ الإعتبارات الوجدانية المشتركة كالتسليم بحقيقة الواقع الموضوعي العام.
ويمكن عدّ جميع هذه الحقائق المشتركة ثابتة باستثناء الأولى، بإعتبارها نسبية وتخضع لإعتبارات منطق حسابات الإحتمال والترجيح.
6ـ
كما أن هناك نوعاً آخر من الإعتبارات المشتركة يخص قضايا القيم الأخلاقية،
وهي وإن بدت ثابتة في عدد من القواعد الكلية، مثلما عليه قاعدة العدل، إلا
أن مصاديقها متأثرة بما عليه طبيعة الواقع وتغيراته، لهذا فقد تفضي بعض
المصاديق إلى أن تكون ذات إعتبارات خاصة غير مشتركة. كما قد تتزاحم القواعد
عند تضارب مصاديقها مع بعضها بما يمكن أن نطلق عليه (تزاحم القيم)، كالذي
يحصل أحياناً بين قاعدتي الصدق وحفظ النفس المحترمة (3).
ومن حيث
مصادر المعرفة أنه إذا كان العقل والواقع يفضيان تارة إلى إعتبارات مشتركة،
وأخرى غير مشتركة، فإن الأمر مع النص الديني يختلف، إذ أنه لا يسفر إلا عن
إعتبارات خاصة؛ رغم أنها قد تكون مدعومة بإعتبارات مشتركة من العقل أو
الواقع.
ويمكن تطبيق فلسفة الإعتبارات على المجالات الإنسانية
المختلفة، كالنواحي النفسية والإجتماعية والحضارية وغيرها. فكل طرف في هذه
النواحي يرتبط مع الآخر بإعتبارات ذاتية وعارضة، كما ويرتبط معه بإعتبارات
خاصة ينفرد فيها الطرف لنفسه، وإعتبارات عامة يشترك فيها مع غيره. فمثلاً
أن الحضارات العالمية تختلف فيما بينها بنواحي بنيوية خاصة، يمكن أن تميز
حضارة ما عن أخرى، لكن مع هذا الإختلاف هناك مشتركات تجمع بين الحضارات
وتجعلها أقرب إلى النزعة الإنسانية العامة بما تحمله من قيم متقاربة في
نواحي عديدة، ومنها القيم الأخلاقية العليا.
ومثلما تتصف المصادر
الذاتية بالثبات والإتفاق بين المنتمين للفكر المعني، فإن المصادر العارضة
يسود فيها التغير والإختلاف. فمثلاً في العلم الحديث للطبيعة تُعد التجربة
والإختبار أبرز محددات المصادر الذاتية لهذا العلم، لكن يضاف إليها مصادر
عارضة بعضها ميتافيزيقية وأخرى تتعلق بما يطلق عليه الحدس والخيال، أو غير
ذلك. وبالتالي فلو أن المصادر العارضة تغيرت أو انتفت فإنها سوف لا تغير من
طبيعة خصوصية العلم الطبيعي وهو أنه قائم على الإختبار والتجريب، بخلاف
الحال فيما لو انتفى الإختبار كلياً، حيث أن ذلك يزعزع الطريقة العلمية
بأكملها ويجعلها نمطاً آخر من التفكير (4).
وتتحدد المصادر الذاتية
للفكر الإسلامي بالنص أو الكتاب والسنة، وإذا كانت السنة شارحة للكتاب
وتبياناً له؛ فسيقتصر الأصل على الكتاب. أما المصادر العارضة فتتنوع وتختلف
بحسب الفرق والإتجاهات، ومن هذه المصادر العقل الكلامي والعقل الفلسفي
والذوق الكشفي، وكذا القياس والاستصلاح والإستحسان، وغير ذلك من المصادر
والإعتبارات.
ولو عدنا إلى المصادر الذاتية فسنجد أن أبرز قضاياها
المعتبرة هي نظرية التكليف، لكثرة ما تشهده من القرائن الدالة عليها، وهي
من حيث كونها أبرز القضايا فإن ذلك يجعلها المحور الذي يدور حوله الفكر
الإسلامي والديني عموماً، وبالتالي فإن هوية هذا الفكر محددة بهذه النظرية.
وتتضمن
نظرية التكليف أربعة محاور هي موضع إتفاق المسلمين إجمالاً، وإن اختلفوا
حولها تفصيلاً، وهي كما عرفنا بالتحديد: المكلِّف والمكلَّف ورسالة التكليف
وثمرة التكليف.
لكن إذا أخذنا بإعتبار أن كل فكر وعلم يمكن تقسيمه
منهجياً إلى نوعين من الفكر: أحدهما (في ذاته)، والآخر (متحقق)، فسيصبح
الفكر الإسلامي بما هو في ذاته معبّراً عن تلك الهوية المجملة من نظرية
التكليف، وأنه بهذا الشكل يحمل الإعتبارات الذاتية لا العارضة، لكنه من حيث
كونه فكراً متحققاً فذلك يعني النظر إليه من حيث تجسده في التراث المعرفي
فعلاً (5). وتعد الإعتبارات العارضة العامل الأهم الذي يقوم بتحديد طبيعة
الفكر المتحقق. فعليها يتنوع الفكر ويتجدد، بل وبها يصبح الفكر قائماً على
الجمع لا الطرح.
لذا فالفضل في تعدد الفكر الإسلامي يعود - في
الغالب - إلى الإعتبارات العارضة، ومن ذلك أن أغلب الطرق المعرفية لهذا
الفكر قائمة على الإعتبارات العارضة لا الذاتية. لذلك أخذت نظرية التكليف
تقرأ - تبعاً للإعتبارات العارضة - برؤيتين متعارضتين في مرآتين مختلفتين
تمام الإختلاف. ونقصد بذلك الفهم المتعلق بنظرية التكليف تبعاً لنظام
المتشرعة كعلماء الفقه والكلام من جانب، والفلاسفة والعرفاء من جانب آخر،
ففي الغالب أن كليهما اعتمد على الإعتبارات العارضة.
وبعبارة أخرى،
أنه من الناحية المنطقية ينقسم الفهم الديني إلى نوعين مختلفين من
الإعتبارات، هما الإعتبارات الذاتية للفهم كما تبرزه الدائرة البيانية
(النقلية)، والإعتبارات العارضة له كما يتجلى لدى الدوائر المعرفية الأخرى.
وعلى
العموم أنه لما كان لكل علم إعتباراته المختلفة، وأن بعض هذه الإعتبارات
ذاتية والاخرى عارضة، لذا فمن المتوقع حصول درجات وأنواع مختلفة من
التعارض، فقد تتعارض الإعتبارات العارضة مع بعضها البعض، كما قد تتعارض
الإعتبارات الذاتية مع بعضها، وكذا يمكن أن تتعارض الإعتبارات العارضة مع
الذاتية، وقد يمتد التعارض ليكون بين الإعتبارات العارضة من جهة، والحقائق
الأصلية أو حقائق الموضوع الخام - كحقائق النص العامة مثلاً – من جهة
ثانية. فالإعتبارات العارضة قائمة بدورها على موضوع خام آخر ليس هو ذاته
الذي تقوم عليه الإعتبارات الذاتية، الأمر الذي يعني وجود مدارات مختلفة من
التفكير يتنافس بعضها مع البعض الاخر، ومن ذلك التنافس بين مدار التفكير
العارض الذي تنشأ عليه الإعتبارات العارضة، ومدار التفكير الذاتي الذي تنشأ
عليه الإعتبارات الذاتية، وحيث هناك مداران للتفكير، أحدهما ذاتي وآخر
عارض، أو قل أن لدينا موضوعين كلاهما يتصفان بالخام، ولهما حقائقهما
المنكشفة المستقلة، أحدهما ذاتي، والآخر عارض، فهذا يفضي إلى حصول نوع من
التنافس وربما الصراع والصدام، حيث لكل منهما إعتباراته الخاصة، وهي
الإعتبارات الذاتية والعارضة. وقد يفضي الصراع إلى أن يكون صداماً بين
الإعتبارات العارضة وحقائق الموضوع الذاتي، ومن أبرز الشواهد عليه ما حصل
مع النظام الفلسفي والعرفاني، حيث أسفر التفكير ضمن مداره الوجودي العارض
إلى نتائج لا تتفق مع موضوع النص الخام أو حقائقه الأصلية (6).
وبالتالي
فالمشكلة - هنا - ليست في النزاع الحاصل بين الإعتبارين الذاتي والعارض
للفهم والتفكير، إذ كلاهما يعبّر عن فهم وتفكير إجتهادي، إنما المشكلة في
الصدام الذي قد يحصل بين التفكير العارض من جهة، وبين الحقائق الأصلية
للموضوع الذاتي من جهة ثانية. مثلما قد يحصل الصدام بين التفكير الذاتي من
جانب، وبين الحقائق الأصلية للموضوع العارض من جانب آخر. فالتفكير الذاتي،
وهو في قضيتنا عبارة عن التفكير البياني، قد يتحول إلى ما يشكل صداماً مع
الحقائق الأصلية للموضوع العارض؛ كالعقل والواقع والوجود.
ومن
الناحية النقدية، أن جميع الطرق المتحققة للفكر الديني، بإعتباراتها
الذاتية والعارضة، قد عانت من مشاكل مزمنة أساسية ثلاث، كالتالي:
الأولى: أنها لم تمارس المراجعة النقدية المتواصلة لفحص مفاهيمها ومقولاتها، لكونها من المذاهب الدوغمائية التي لا تشكك في مقالاتها.
الثانية:
أنها غيبت الإعتبارات الخاصة بالواقع، فحتى الإتجاهات العقلية كانت
إتجاهات تجريدية، أو أنها تعاملت في الغالب وفق العقل القبلي وليس البعدي،
بل لم يحصل آنذاك تمييز بين هذين النوعين من العقل.
الثالثة: أنها
إستندت في الأساس إلى الإعتبارات المعرفية الخاصة دون المشتركة. بل وأن
إعتباراتها والنتائج المترتبة عليها كانت تجريدية في كثير من الأحيان،
الأمر الذي يصعب إخضاعها للإختبارات الواقعية المباشرة. وهذا يعني أنها
تقوقعت ضمن دوائر مغلقة من التصورات والمنظومات الذهنية التي يتعذّر
إختراقها وفحصها من الخارج، أو جعلها تحتكم إلى المنطلقات العامة المتمثلة
بالواقع والأصول العقلية المشتركة، وكل ما يمكن فعله هو الفحص المنطقي غير
المباشر (7)، وكذا الفحص الضمني لتبيان ما قد تفضي إليه من تعارضات ذاتية
أو ضمنية. ومن أمثلة الإعتبارات الذاتية المتعارضة في المنظومات المغلقة؛
ما جاء عن الفكر العرفاني حول العذاب وعلاقته بالأسماء. فهناك إعتبارات
حكمية وعرفانية متناقضة، فمن الإعتبارات الدالة على عدم الخلود في العذاب
ما ذكره صدر المتألهين في عدد من كتبه - كالشواهد الربوبية وغيرها - وهو أن
القسر لا يدوم في الطبيعة وأن لكل موجود غاية يصل إليها يوماً، كذلك أن
الرحمة الإلهية وسعت كل شيء. لكن في قبال هذه الإعتبارات هناك إعتبارات
أخرى منافية دالة على العذاب الدائم، كالقول بأن النفوس خاضعة للأسماء
الإلهية، وأن من الأسماء الإلهية ما يظهر بمظاهر الإنتقام والعذاب، وأن من
مقتضيات الأعيان الثابتة هو أن تكون على ما عليه بعد أن يفاض عليها الوجود،
فالسعيد من سعد في بطن أمه والشقي من شقي في بطن أمه. وكذا يمكن أن يقال
حول نظرية الفلاسفة في الصدور وما تتضمنه من تعارضات ضمنية (. وأيضاً هو
الحال مع ما جاء في نظام المتشرعة (المعياري) من إعتبارات تجريدية وضمنية
متعارضة، كالموقف من بعض قضايا الحسن والقبح وغيرها (9).
***
كانت
هذه نقاط ضعف الإتجاهات المعرفية للفكر المتحقق، بلا فرق بين تلك التي
عولت على الإعتبارات الذاتية أو العارضة. فالأولى انطلقت من مقولة (إنما
أُمرنا أن نأخذ العلم من فوق)، أي من النص (10). أما الثانية التي تشعبت
بها الطرق والإتجاهات فأغلبها تجريدية؛ إما بحكم موضوعاتها الخاصة، أو لأن
معالجتها للقضايا المعرفية كانت تحت سلطة العقل القبلي. وعليه فلو أردنا
إيجاد فكر متحقق جديد يتجنب الوقوع فيما وقع به الفكر المتحقق التقليدي؛
لكان لا بد من الأخذ بالنقاط التالية (11):
1ـ لا غنى عن المراجعة
النقدية المتواصلة للفكر الديني، أي مراجعة نقد الذات على التواصل. إذ لا
يمكن تحقيق تطور نوعي ملحوظ من غير هذا المبدأ، كالذي حصل مع العلم الحديث
في قطيعته مع القديم (12).
2ـ احضار الواقع بقوة ضمن مفاصل الفكر الديني، واحضار الدراسات التي تخص واقع الإنسان وحقوقه.
3ـ
تقليص الإعتبارات الذاتية مع توسعة الإعتبارات العارضة. وهذا ما يتطلب
العمل بجعل الأولى مجملة، على خلاف الثانية، سيما تلك التي تتعلق بالإنفتاح
على الواقع. والجمع بين هذين النوعين من الإعتبارات يتيح لنا أن نجعل من
الإعتبارات الذاتية موجهات دون أن يكون لها سلطة ذهنية تكوينية، خلافاً
للإعتبارات العارضة كما تتمثل بالواقع (13).
4ـ العمل على تفعيل
الإعتبارات العارضة المشتركة لا الخاصة. فقد جرّب الفكر المتحقق الديني
العمل وفق الإعتبارات الخاصة دون نجاح، وهو لم يجرّب بعد العمل وفق
الإعتبارات المشتركة. وحيث أن هناك نسقاً منطقياً يتحكم في العلاقة بين
المعرفة والوجود والقيم، لذا كانت المهمة الملقاة على عاتق الإعتبارات
المشتركة؛ الإنطلاق من البعد المعرفي ليتم بناء كل من النسقين الوجودي
والقيمي، وأخص بالذكر - هنا - ضرورة الارتكاز على منطق الإحتمال والإستقراء
في التكوين المعرفي.
* صراع المعيار والوجود في تمثيل الفكر الإسلامي:
يمكن
تقسيم علوم التراث ذات العلاقة بفهم النص والخطاب الديني إلى قسمين. فهناك
علوم تمهيدية متخصصة ومحايدة لا علاقة لها بشكل مباشر بفهم الخطاب، وإن
وظفت لهذا الغرض، كعلوم العربية والتاريخ والرجال والمنطق وما على شاكلتها.
وفي قبالها توجد علوم لها علاقة ماسة بهذا الفهم طبقاً لما تحمله من أدوات
معرفية وتأسيسات قبلية فرضت نفسها على آلية الفهم مباشرة، كعلم الكلام
والفقه والتفسير والحديث والتصوف والفلسفة...الخ.
ومع أن موضوعات
المجموعة الثانية من العلوم مختلفة، إذ لكل علم موضوعه الخاص، فما لعلم
الكلام هو غير ما لعلم الفقه من موضوع، وكذا الحال مع التفسير والحديث
والفلسفة والتصوف، فلكل من هذه العلوم معالجته الخاصة واستقلاليته النسبية،
لكنها مع ذلك تشترك في إخضاع الخطاب الديني للفهم. وعليه لو أنا اعتبرنا
الموضوع المشترك الجامع لهذه العلوم هو فهم الخطاب بالذات؛ لأصبحت بمثابة
علم واحد متعلق بهذا الفهم، ولكان من الممكن تقسيمها قسمة أخرى بحسب علم
الطريقة. إذ لا تشكل تلك الأجزاء والأقسام كتلاً مستقلة لكل منها موضوعها
المحدد، بل تقترب بعض الكتل من بعض، أو تندك بها لإتحاد طريقتها العامة في
الفهم.
فمن وجهة نظر «طريقية» تُصنف هذه العلوم ضمن كتلتين كبيرتين،
لكل منهما روحها الخاصة من النظر والتفكير، إلى الحد الذي تتضارب فيه
إحداهما مع الأخرى، وإن تداخلا على مستوى السطح والظهور التاريخي، كما يظهر
لدى المفكرين الذين حاولوا التوفيق أو التلفيق بينهما. فبحسب التحليل
الإبستمولوجي أن القطيعة والمنافاة بينهما ليست محايثة ولا تاريخية، بل
منطقية ذاتية جوانية، بغض النظر عن المجرى التاريخي لهما.
فكتلة
علوم الكلام والفقه وغالب تفسير القرآن والحديث؛ تتخذ إتجاهاً محدداً في
قبال كتلة الفلسفة والعرفان أو التصوف. فكل من الكتلتين يعبّر عن نظام
معرفي قائم في ذاته يتنافى جذراً وروحاً عن الآخر. ولا يعود السبب في هذا
التنافي المعرفي إلى إختلاف الموضوع الذي يعالجه النظامان من حيث الأساس.
فمع أن الفلسفة والعرفان تتعاملان مع موضوع «الوجود» قبل تعاملهما مع
الخطاب الديني، بخلاف الحال مع النظام الآخر، إلا أن هذا التمايز ليس هو
السبب في مصدر التضارب المنطقي بين النظامين، فمن المعلوم أن علوم النظام
الآخر تعالج أيضاً موضوعات جزئية مختلفة، ومع هذا فليس بينها منافاة من
النوع الذي أشرنا إليه. كما لا يمكننا أن نرجع السبب في مصدر التضارب
المعرفي للنظامين إلى الإختلاف في وجهات النظر بينهما هنا وهناك، إذ لا
يخلو أي نظام وجهاز معرفي من كثرة الخلاف، بما فيها الخلافات الكبيرة، ومع
ذلك لا يعني أن بينها قطيعة ومنافاة، على الصعيد المنطقي العام. يضاف إلى
أنه لا يسعنا إرجاع مصدر التضارب إلى إختلاف طريقة الاستدلال الصورية، إذ
هما كثيراً ما يشتركان في هذه الطريقة. يبقى أن نقول بأن مصدر التضارب يعود
إلى التباين الشاسع في الروح العامة لنمط التفكير لدى كل منهما، فطبيعة
المعرفة لكل منهما هي ليست من جنس الثانية، إلى الحد الذي يجعل من موضوع
البحث المشترك، وهو الخطاب الديني، يتمظهر بمظهرين لكل منهما الجنس المختلف
كلياً عن الجنس الآخر. ولنقل أن لكل منهما مرآته الخاصة المختلفة جذراً عن
الأخرى. لذلك لم تفض عمليات التوفيق بين الطبيعتين تاريخياً إلا إلى نوع
من التأسيس الجديد لصالح إحداهما على حساب الأخرى. فالتضاد بينهما هو تضاد
بين روح حتمية وأخرى غير حتمية، وليس من الممكن الجمع بينهما دون خسارة
إحداهما لحساب الثانية. وبالتالي فإن ذلك يدفعنا إلى القول بضرورة دراسة
هاتين الروحين كموضوعين في ذاتيهما بغض النظر عن العناصر الصورية المحايدة
التي توظفها كل منهما.
ومع أن من السهل أن تجد عالماً يجمع بين
الفلسفة والعرفان كما هو غالب الفلاسفة، أو يجمع بين الكلام والفقه كما هو
غالب المتكلمين، لكن يقل وجود من يجمع بين علوم الكتلة الأولى من جهة،
وعلوم الكتلة الثانية من جهة أخرى، سيما الجمع بين الفلسفة والفقه، كما هو
حال إبن رشد، وبأقل من ذلك من يجمع بين الفلسفة والكلام، كالذي يلاحظ لدى
الكندي، لكن الكندي عالم طبيعي ذو نزعة كلامية اعتزالية أكثر منه فيلسوف
محترف على شاكلة سائر الفلاسفة التقليديين؛ لكونه يتجاوز المبادئ الفلسفية
مثل موقفه من خلق العالم.
فعلاً أن هناك خروقات حصلت للكثير من
الفلاسفة والعرفاء عندما تناولوا القضايا الدينية، ومنها تلك التي عالجها
علم الكلام. فمثلاً أن لإبن رشد رأياً حول القضاء والقدر يخالف مبناه
الفلسفي. فهو يتوسط في حل المشكلة ويرى أن إرادتنا للأشياء لا تتم إلا
بمؤاتاة الأسباب الخارجية والداخلية - في أبداننا - التي سخّرها الله
تعالى، والتي منها ما يكون حافزاً على الفعل أو مثبطاً له. بهذا تجري
الأفعال على نظام محدود مقيّد بالأسباب والإرادة معاً، حيث كلاهما يشكل
الحد العام للقضاء والقدر الذي كتبه الله تعالى على عباده (14). لكن مع ذلك
فهذه الرؤية تخالف مبنى إبن رشد الفلسفي وحتمية نظام الضرورة في الأسباب
والمسببات في الوجود كله من أوله حتى آخره (15).
كما أن لصدر
المتألهين آراءاً حول خلق السماوات والأرض تتعارض مع مبانيه الفلسفية. ومن
ذلك جمعه بين الإعتبارات الفلسفية القائلة بضرورة أزلية الفيض وأبديته
وإستحالة عدم الكائنات أو خلقها من العدم تبعاً لمنطق السنخية، وبين
الإعتبارات الدينية التي تقر بأن الله قادر على أن يخلق السماوات والأرض في
لحظة واحدة (16)، كما وله القدرة على إفنائهما متى شاء في أي لحظة (17)،
وأن الدنيا ستفنى بقيام الساعة الكبرى. كذلك إعتقد تبعاً للمنطق الفلسفي
أنه لا بد للعقول المجردة أن تظل ثابتة لا تتعرض للتغير والتحول بإعتبارها
ليست من جملة العالم ومما سوى الله، بل باقية ببقائه وموجودة بوجوده من دون
جعل وتأثير (18). لكنه مع ذلك أقر بفناء العقول ورقيها بالتحول إلى ما هو
أعلى منها شأناً، تلفيقاً مع بعض النصوص الدينية التي صرحت بموت وفناء الكل
(19).
وبالتالي فما نود قوله هو أن واقع الفلاسفة والعرفاء
والمتكلمين وحتى الفقهاء؛ لا يعكس بالضرورة الإتساق مع المبادئ الفلسفية
والعرفانية والكلامية والفقهية الملتزم بها دائماً، سيما الأصول المولدة
وتفريعاتها.
***
من المعلوم قبل كل شيء أن لنظام الفلسفة
والتصوف وجوداً مستقلاً سبق وجود الخطاب الديني أو الإسلامي لمدة تناهز
عشرة قرون خلت. وكانت إشكاليته المعرفية هي إشكالية «وجودية» تتخذ من
«الوجود العام» موضوعاً لها، مضفية عليه الطابع الحتمي في جميع مراتبه
ومفاصله. لذا آثرنا تسميته بـ (النظام الوجودي) الحتمي، فما قدّمه من تنظير
يمتاز بالطابعين الوجودي والحتمي معاً، حتى على مستوى تعامله مع الخطاب
والقضايا المعيارية، كما فصلنا ذلك في (الفلسفة والعرفان والإشكاليات
الدينية).
أما علوم النظام الآخر فقد نشأت بعد وجود الخطاب الديني،
وقد علقت بهذا الخطاب بشتى الأشكال والنواحي، لذلك لم يكن هناك مانع يفصلها
عن فهمه مثلما هو الحال مع النظام الوجودي. فموضوعها الأساس إن لم يكن عين
النص أو الخطاب ذاته، فهو لا يخرج عن القضايا التي تتعلق به مباشرة هنا
وهناك. وعليه فمن حيث ذاتها أنها ليست مستقلة، ولا كان بالإمكان معالجتها
وقراءتها بمعزل عن العلاقة بالنص أو الخطاب، خلافاً لما هو الحال مع النظام
الوجودي، لكونه مستقلاً بذاته، وبالتالي فمن الناحية المنطقية جازت
معالجته لذاته وبغض النظر عن علاقته بالنص. وهو ما اضطرنا إلى المغايرة في
الطرح بين القراءتين المخصصتين لهذين النظامين، إذ سنفرد للنظام الوجودي
باباً من المعالجة قبل احتكاكه بالنص وعلاقته بفهمه، لنتعرّف عليه كشيء
مستقل في ذاته وبغض النظر عما قدّمه من طريقة فهم. ولم نفعل الشيء ذاته مع
النظام الآخر لإلتصاقه بالفهم كما أشرنا.
لكن لما كانت علوم النظام
الآخر غير مستقلة في ذاتها عن الخطاب، فهي إما مبنية على فهمه أو على
الموضوعات العالقة بأجواءه، وحيث أن للخطاب طبيعة معيارية تتضمن «الروح
الانشائية» وتتخذ من نظرية التكليف قطبها الأساس، لذا فقد اصطبغت هذه
العلوم بالصبغة المعيارية، أي أنها تنتمي إلى ما نطلق عليه «النظام
المعياري»، دون أن يعني ذلك بأن الخطاب هو الآخر ينتمي إلى هذا النظام،
بإعتباره مادة خام بالقياس إلى الأنظمة والأجهزة التي تطرح نفسها لفهمه
ومعالجة قضاياه.
ومصطلح (المعياري) جاء ليقابل مصطلح الوصفي
والتقريري للأشياء الخارجية، فمعناه هو ما ينبغي عليه الشيء أن يكون. وفي
بعض المعاجم الفلسفية عُرّف (المعيار) لدى المنطقيين بأنه نموذج مشخص لما
ينبغي أن يكون عليه الشيء، وهو النموذج المثالي الذي تنسب إليه أحكام
القيم، فالمعيار في الأخلاق هو النموذج المثالي الذي تقاس به معاني الخير،
والمعيار في المنطق هو قاعدة الإستنتاج الصحيح، وفي نظرية القيم هو مقياس
الحكم على قيم الأشياء. والعلوم المعيارية هي عند (ووندت) عبارة عن العلوم
التي تهدف إلى صوغ القواعد والنماذج الضرورية لتحديد القيم، كالمنطق
والأخلاق وعلم الجمال. وتقابل هذه العلوم نظيرتها المسماة بالعلوم
التفسيرية أو التقريرية القائمة على ملاحظة الأشياء وتفسيرها، كما في علوم
الطبيعة، فهي علوم خبرية خلافاً للعلوم المعيارية التي يمكن تسميتها
بالعلوم الإنشائية (20). وبالتالي فما نعنيه بالنظام المعياري لدى الفكر
الإسلامي هو التفكير في مجال القيم بما ينبغي عليه الشيء أن يكون.
لذا
فمن حيث الدقة، أن الفارق بين النظرتين الوجودية والمعيارية هو أن النظرة
الوجودية ترى الأشياء من حيث ذواتها وصفاتها وعلاقاتها الكينونية. في حين
تترصد النظرة المعيارية البحث في الفعل الإرادي ودوافعه النفسية وما ينطوي
عليه أو يقتضيه من صفات وعلاقات انشائية أخلاقية لا كينونية. فشرط الوجود
هو الذات، وبالأساس الذات الإلهية، فمن خلالها تتشخص طبيعة النظرة إلى سائر
الوجودات. بينما شرط «المعيار» هو القدرة والإرادة، فبها يمكن الحديث عن
الخصال المعيارية للفعل أو السلوك الحر. وبالتالي فلولا الذات ما كان
للوجود وجود، كذلك فلولا القدرة والإرادة ما كان للمعيار عيار. وبهذا
التمايز بين النظرتين (الوجودية والمعيارية) يمكننا أن نتفهم طبيعة التفكير
لدى كل منهما.
فميزة النظام الوجودي عن النظام المعياري هو أن
الأول لا يشرّع إلا بأخذ إعتبار «الوجود» ولأجله. فحتى القضايا المعيارية
تكون محددة ومقاسة طبقاً لـ «الوجود». بينما ينعكس الحال في النظام
المعياري، سواء في دائرته العقلية أم البيانية. إذ يقوم التشريع فيه على
«المعيار» ولأجله؛ بما في ذلك تحديد قضايا الوجود وإعتباراته. فبحث الدائرة
البيانية حول (المشكل الوجودي) كما يتمثل بالصفات الإلهية لا يخرجها عن
الطبيعة المعيارية، فهي تعالج هذا المشكل إعتماداً على بيان النص وتبعاً
للدوافع اللاهوتية. أما الدائرة العقلية فمن الواضح أن محور إهتمامها يتمثل
بالعلاقة التكليفية التي تربط المكلِّف بالمكلَّف، وهي حتى في تعاملها مع
القضايا الوجودية، كبحثها في الأمور الفيزيقية والميتافيزيقية، تنطلق في
الغالب من الدافع اللاهوتي. ويصدق هذا الأمر على الإتجاهات التي انقسمت على
نفسها بين عدد من الدوائر، كمذهب الأشاعرة المتقدمين، فهو في تحديده
لقضايا الصفات كمشكل وجودي يتبع المنهج البياني بخلفياته اللاهوتية، أما
بالنسبة لقضايا العلاقة التكليفية فإنه يتبع المنهج العقلي. أي أنه منقسم
على ذاته بين الدائرتين ومتمشكل بكلا المشكلتين (الوجودية والمعيارية).
فالغرض
من الإهتمام الغالب بعلوم الكلام والفقه وتفسير القرآن والحديث وما على
شاكلتها هو لتحديد العلاقة المعيارية لنظرية التكليف، فهي قطب الرحى الذي
تدور حوله هذه العلوم. فليس هناك موضوع في ذاته ولأجله تقوم عليه تلك
العلوم أشد وأقوى من هذه النظرية بما تنطوي عليه من تحديد لعلاقات الحق بين
المكلِّف والمكلَّف. فمن حيث الأساس أن نصوص الخطاب الديني دالة على
التكليف، بل هي عين التكليف ذاته، وهو ما جعل تلك العلوم التي قنّنت هذه
النصوص تتجه هي الأخرى بإتجاه هذه القضية المركزية. فدائرة البحوث الفقهية
هي عينها دائرة علم التكليف، فقد شهد الفقه تضخماً في البحث والتقنين خلال
القرون الأولى، وامتص من الطاقات الفكرية ما يكفي أن نعرف أنه منذ القرن
الأول حتى القرن الرابع الهجري ظهرت إتجاهات كثيرة من المدارس الفقهية؛
قدّرها البعض بما لا يقل عن تسع عشرة مدرسة (21)، كل ذلك لغرض تحديد دوائر
التكليف طولاً وعرضاً. ومع أن الإجتهاد الفقهي تكفّل بتحديد دوائر التكليف
لإبتلاء طاعة المسلمين في شؤون ممارساتهم العملية؛ إلا أنه هو الآخر كان
خاضعاً لذات التكليف. وكما قرر الشافعي بأن الله قد ابتلى طاعة المسلمين
«في الإجتهاد كما ابتلى طاعتهم في غيره مما فرض عليهم» (22).
كذلك
الحال مع علم الكلام، فقد لجأ هو الآخر إلى تحديد التكليف مباشرة بما هو
«موضوع في ذاته»، فهناك مباحث عامة عن التكليف وشروطه وعلاقته بالعدل
وإرادة الإنسان، كما أن مقدمات كتب هذا العلم قد ألِفت أن تشرع بالبحث عن
وجوب العلم، وعما يجب على الإنسان أن يعرفه أولاً، وعن تحديد عقيدة الفرقة
الناجية وسط فرق الضلال. فأصبح التكليف مقدمة للكلام، بل أصبح الكلام
تكليفاً، فبنظر أصحاب الكلام تعتبر قضايا هذا العلم الأساسية من التكاليف
الواجب على المسلم بحثها عيناً لتحديد عقيدته سلفاً. فمثلاً ذكر الباقلاني
في كتابه (الإنصاف) ما يجب إعتقاده ولا يجوز الجهل به، فعدّد مختلف قضايا
الكلام الأشعرية، وأضاف إليها العلم بأوائل المعرفة وأصول الأدلة والمقصود
بالاستدلال وإنقسام المعلومات والموجودات والمحدثات، كما أوجب على المكلَّف
معرفة أول نعم الله على خلقه وأفضلها عند المؤمنين المطيعين وغيرها من
القضايا الأخرى (23). ومعلوم أن الباقلاني أذاع مبدأ (بطلان الدليل يؤذن
ببطلان المدلول) خلال القرن الرابع الهجري، لذلك فقد زاد من حمولة التكليف
فشملت قضاياه حتى الأدلة المحررة، إذ خرجت من كونها في دائرة ما هو «موضوع
لأجله» لتدخل دائرة ما هو «موضوع في ذاته» من التكليف، الشيء الذي يعني أن
الكلام قد أصبح «شريعة»، والإجتهاد «نصاً». فلما كان الاستدلال على بعض
العقائد، كالقدرة والخلق، متوقفاً عند الباقلاني على إثبات الخلاء والجوهر
الفرد والعرض لا يبقى زمانين وغيرها (24)، لذا فقد اعتبر هذه القضايا ضمن
العقائد الواجب إعتقادها، وبالتالي فهي قضايا وجودية مؤسسة على المعيار،
خلافاً لطريقة الوجوديين، لكونهم يؤسسون المعيار على الوجود لا العكس.
بل
لدى المعياريين أن مبرر وجود الخلق هو لغرض معياري يتعلق بالتكليف، إذ
سُخّرت الأشياء للإنسان ليعتبر منها ويتخذها مرشداً ودليلاً على التكليف،
بما في ذلك التكاليف العقلية، كما يلاحظ - مثلاً - لدى الذين اعتبروا الغرض
من وجود الشهوات في الإنسان إنما لأجل التكليف (25)، طبقاً لإعتبار
المقدمات والنتيجة التالية:
1ـ إن طبع الناس يميل إلى فعل القبيح بسبب وجود الشهوات.
2ـ لو ترك الناس من غير تكليف لفعلوا القبيح.
3ـ إن ترك الناس على هذا الحال يعني إغراءً لهم على فعل القبيح.
4ـ إن هذا الإغراء على فعل القبيح هو عبث وقبيح.
5ـ ومن ثم فإن العبث والقبيح لا يجوزان على المولى تعالى.
6ـ وحيث أنه إذا كان هناك غرض في فعله تعالى؛ فلا يحصل هذا الغرض إلا بالتكليف، وهو المطلوب إثباته (26).
كما
ذهب الحر العاملي إلى أن الحكمة من خلق الشهوات والشياطين وغيرها تتمثل
بالتكليف والتعريض لزيادة الثواب، وكذا هو الحال مع نصب الشبهات وانزال
المتشابهات (27).
كان ذلك مما له دلالة على البحث الكلامي بما هو
«موضوع في ذاته» من التكليف. أما البحث الكلامي بما هو «موضوع لأجله» فإنه
يستغرق ما تبقى من مواد علم الكلام، ويتوارى في كثير من الأحيان وراء
الأدلة المحررة، بما في ذلك أدلة إثبات أصول العقائد كالتوحيد والعدل، فرغم
تضاربها بحسب الميول المذهبية إلا أنها تهدف إلى التنزيه والتقديس بعيداً
عن شبهة التدنيس ومخالفة الشريعة، بغية ضمان «الإعتقاد الحق»، لذلك لا يخلو
لسانها من التعريض بكل من يخالف هذا الحق، بالتكفير والتضليل، مما له
دلالة على «التكليف» بوصفه معياراً يتوارى خلف لغة الكلام وعلمه.
يضاف
إلى أن نشأة علم الكلام ومجادلات «الصخب» التي ظهرت في أوساطه، لم تتجاوز ـ
هي الأخرى ـ حدود ذلك المعيار. فقد نشأ الإعتزال على يد (واصل بن عطاء)
بعد اعلان رأيه حول «منزلة الفاسق» (28)، بل أن أغلب أصول المعتزلة الخمسة
لها دلالة معيارية على التكليف. كما أن الأشاعرة هي الأخرى لم تستقل عن
المعتزلة ولم تنفصل عنها إلا بعد إحساسها بما ضيعته من «واجب التكليف»،
وذلك بعد المناقشات التي دارت بين الأشعري واستاذه الجبائي حول قضايا لها
علاقة صميمة بنظرية التكليف، كقضية الصلاح والأصلح.
ويلاحظ أن
الممارسة العقلية لعلم الكلام تقف على الضد والتنافي مع الممارسة العقلية
للفلسفة التقليدية. فالنظام الذي ينتمي إليه كل منهما هو على الضد من
الآخر. فبحسب الفهم الطريقي أن العقل الكلامي هو عقل معياري خلافاً لما
يتصف به العقل الفلسفي من صفة وجودية غير معيارية. وبالتالي فإن الروح
المعرفية وطريقة التفكير ونوع النتائج لكل منهما هي مختلفة تماماً.
وعموماً
يمكن القول بأن منهج علم الكلام هو أقرب للتفكير الديني، أو أنه ممزوج
بهذا التفكير، وأن أتباعه يحملون عقيدة آيديولوجية مذهبية دينية، وعلى
خلافه منهج الفلسفة المتحرر غالباً من هذه المذهبية، وأنه أقرب للمنهج
العلمي، سيما وأن العلوم الطبيعية كانت في ذلك الوقت تُبحث وتُدرس ضمن
الفلسفة، وأن العلماء كانوا إما فلاسفة أو دائرين في فلكهم. لذلك فالتطور
العلمي الذي حصل خلال تاريخ الإسلام إنما كان بفعل الفلسفة لا الكلام، رغم
بعض مؤاخذاتنا على علاقتها بعلوم الطبيعة، كما سجلناها في كتاب (مدخل إلى
فهم الإسلام). لذا ففي فهم القضايا الدينية يسهل الإنفكاك تماماً من
الفلسفة، لكن من الصعب الإنفكاك من علم الكلام وتفكيره الديني؛ بإعتباره
مختصاً في أسس وأركان هذه القضايا خلافاً للأولى.
وحقيقة، لولا أن
الفلسفة ومعها العرفان قد تعرضا للخطاب الديني بالفهم والتبعية كمنهج؛
لكُنّا قد اعتبرناهما يقعان عرضاً وموازاة في منافسة منطق الدين ذاته. فهما
ينافسان هذا المنطق ومدعياته الأساسية. لذا يصعب عليهما تبرير أصول
المسألة الدينية وأركانها الأربعة، خلافاً لعلم الكلام.
لا يقال بأن
للفلسفة التقليدية المنهج البرهاني، إذ لا تسلّم بشيء ما لم تقم الدليل
عليه، خلافاً للكلام. ذلك أن كلاً منهما يقيم المنهج الاستدلالي طبقاً
للمسلمات الخاصة به، مثلما أشار إلى ذلك إبن رشد (29). بل يمكن القول أن
الفلسفة التقليدية ليست برهانية بإطلاق، بل أنها مقيدة ضمن ما تفترضه من
ماهيات كلية في الذهن، فهي بالتالي ليست برهانية من حيث علاقتها بالواقع أو
انطباقها معه. ويمكن تصوير هذه الناحية بمثال يعود إلى الهندسة الكونية،
فحينما نقول أن مجموع زوايا المثلث هو (180 درجة)، فهذا القول صحيح قياساً
إلى ما نحمله من تصور وإفتراض ذهني، لكنه ليس معنياً بالواقع الموضوعي
فعلاً. فنحن نتعامل مع سطح مستو على الصعيد الذهني، في حين ليس بالضرورة أن
يكون مبنى الواقع بمثل هذا السطح، وبالتالي قد لا يكون مجموع تلك الزوايا
بالقدر المذكور. فمثلاً أن نظرية اينشتاين في النسبية العامة قد عوّلت على
السطح المنحني للهندسة الكونية، وأخذت تصور الواقع بأنه أشبه بقطعة
البطاطس، لهذا كان مجموع زوايا المثلث حسب هذا الإفتراض مغايراً للدرجة
السابقة، خلافاً لنظرية نيوتن في تصورها لتلك الهندسة (30). وهكذا الحال
يمكن قوله حول ما يتعلق بالفلسفة التقليدية.
ويترتب على ذلك أن
الفلسفة والكلام لم يتعاملا تعاملاً محايداً إزاء القضايا التي اعترضتهما،
سيما القضايا الرئيسة للعقيدة الدينية. ومع ذلك فإن لكل منهما إجتهاداته
الخاصة، إلى الدرجة التي يتفقان فيها غالباً على ترجيح الرؤية العقلية على
النص، إذ يعتبرانها قاطعة خلافاً للأخير، لكنهما يختلفان في مضامين تلك
الرؤية تماماً.
كما لعبت اللغة دوراً هاماً وعظيماً، لا فقط في حدود
ما هو «موضوع لأجله» بما تمده من مقدمات لتحديد فهم موارد الأمر والنهي من
التكليف، بل كذلك أنها في مرحلة التقنين قد عبّرت أحياناً عن علم ما هو
«موضوع في ذاته» من أبعاد الفقه والتكليف، فهي الدين بعينه على حد تعبير
أبي عمرو بن العلاء (31)، وكما ينقل البعض قول الجرمي الفقيه بأنه منذ
ثلاثين سنة كان يفتي الناس في مسائل الفقه من كتب سيبويه في النحو (32).
وربما كان القصد من ذلك أنه لا يتجاوز توظيف طريقة سيبويه في النحو كـ
«موضوع لأجله» لا «موضوع في ذاته» من الفقه.
وهكذا هو الحال مع علوم
أخرى كتفسير القرآن والحديث والسيرة وما إليها. فمثلاً رأى جماعة من
العلماء بأن علة وجود المحكم والمتشابه في القرآن هو لغرض تكليفي، إذ كُلّف
الإنسان بالإجتهاد في النظر لمعرفة ما هو محكم وما هو متشابه. وقد ذكر
القاضي عبد الجبار الهمداني في جواب على سؤال عن وجه الحكمة في وجود المحكم
والمتشابه في القرآن فقال: «إنا إذا علمنا عدل الله وحكمته بالدلالة
القاطعة التي لا تحتمل (الخلاف)، نعلم أنه لا يفعل ما يفعله إلا وله وجه من
الحكمة في أفعاله تعالى. وقد ذكر أصحابنا في ذلك وجوهاً لا مزيد عليها.
أحد الوجوه: أنه تعالى لما كلفنا النظر وحثنا عليه ونهانا عن التقليد
ومنعنا منه، جعل القرآن بعضه محكماً وبعضه متشابهاً، ليكون ذلك داعياً إلى
البحث والنظر وصارفاً عن الجهل والتقليد. والثاني أنه جعل القرآن على هذا
الوجه ليكون تكليفنا به أشق، ويكون في باب الثواب أدخل، وذلك شائع. فإن
القديم تعالى إذا كان غرضه بالتكليف أن يعرضنا إلى درجة لا تنال إلا
بالتكليف، فكل ما كان أدخل في معناه كان أحسن لا محالة» (33). وعلى هذه
الشاكلة ذكر الزركشي بأن الله جعل كتابه محكماً ومتشابهاً ليحثهم على
التفكير فيه ومن ثم يثيبهم على قدراتهم وجهودهم الإجتهادية (34).
وهناك
من المعياريين من جعل العلوم كلها موضوعة لنظرية التكليف، كابن حزم
الاندلسي، إذ ذكر بأن الغرض من وجودنا في الدنيا هو تعلم ما أراده الله
تعالى منا وأخبرنا عنه، وهو معرفة الشريعة والعمل بموجبها للتخلص من البلاء
الذي ابتلانا الله تعالى به في الدنيا. فقد ربط إبن حزم العلوم بهذه
الغاية المعيارية. وعلى رأيه أنه لا تتم صحة معرفة الشريعة إلا بمعرفة
أحكام الله وعهوده في كتابه المنزل، وكذلك بمعرفة ما بلّغه النبي (ص) إلينا
وما أوصانا به، وأيضاً ما أجمع علماء الديانة عليه وما اختلفوا فيه، وكل
ذلك لا يتم إلا بمعرفة الرجال الناقلين لتلك الأمور وأزمانهم وأسمائهم
وأنسابهم، ومعرفة المقبولين منهم وتفرقتهم عن غيرهم. كما أن ذلك لا يتم إلا
بمعرفة القراءات المشهورة ليوقف بذلك على المعاني المتفق عليها وتمييزها
عن غيرها، وهو لا يتم إلا بمعرفة اللغة ومواقع الإعراب وما يقتضيها من
التعرف على علم الشعر لعلاقة الإعراب به. كما لا بد من التعرف على علم
الهيئة لمعرفة القبلة وأوقات الصلوات، ولا بد من معرفة علم الحساب لتقسيم
المواريث والغنائم وغيرها. كما لا بد من التعرف على حدود الكلام لمعرفة
حقيقة البرهان مما يحتاج إلى علم المنطق والفلسفة. ولا بد أيضاً من معرفة
العيوب التي تجبّ التكليف كعاهة الجنون والآفات المختلفة، وهو ما يحتاج إلى
علم الطب. ولا بد لمعرفة كيفية الدعاء إلى الله من علم الخط والبلاغة وما
إليها. كما أنه لا بد من معرفة عبارات الرؤيا بإعتبارها حقاً «وهي جزء من
ستة وأربعين جزءاً من النبوة»، وهو ما يحتاج إلى التمكن من سائر العلوم
المذكورة. وأخيراً يذكر إبن حزم بأن الحاجة تمت إلى التعرف على علم النجوم
لمعرفة الصواب من الخطأ في القضاء بالنجوم. وبذلك تكون جميع العلوم التي
عرفها هذا المفكر لها غاية معيارية تتمثل في نظرية التكليف (35).
ويلاحظ
أن هناك خصوصيتين للبنية المعيارية داخل النظام المعياري، إحداهما معرفية،
وهي التي تناظر ما عليه النظام الوجودي. أما الأخرى فليس لها ما يقابلها
في النظام الأخير، إذ تتضمن جانباً من الموقف النفسي إتجاه القضايا الدينية
والإحساس بالقداسة، كما يتم التعبير عنها بالحرمة إزاء «معيار» نظرية
التكليف، خشية التفريط بالحق المتعلق بالله أو المكلِّف. فالكثير من علماء
هذا النظام يتحرّجون من أن يضيفوا رأياً من عندهم خارج الحد المتعارف عليه،
خشية تجاوز هذا الحق المعياري؛ بما في ذلك «المسائل الوجودية» التي نصّ
عليها الخطاب، كمسألة ال إستواء على العرش، الأمر الذي يفسّر السبب الذي
جعل أغلب علماء السلف يلجأون إلى التفويض والاحتياط خلال القرون الثلاثة
الأولى للهجرة. وكثيراً ما كان العالم يتخذ من قاعدة الاحتياط موقفاً
عملياً، حتى لو كان رأيه النظري بخلاف ما يؤدي إليه الموقف العملي وما
يستلزمه هذا الموقف من حدوث بعض الأضرار (36). ويذكرنا هذا الأمر بما نقله
الشيخ محمد جواد مغنية عن أحد أساتذته أثناء الدرس حول طهارة أهل الكتاب،
حيث قال الأستاذ: «إن أهل الكتاب طاهرون علمياً نجسون عملياً»، فأجابه
الشيخ بالحرف أيضاً: «هذا إعتراف صريح بأن الحكم بالنجاسة عمل بلا علم».
مما جعل الاستاذ ورفاق الصف يضحكون، كما نقل (37).
ورغم توظيف
النظام المعياري لعلوم العربية لصالحه، سيما ما يتعلق بالدائرة النقلية،
لكن ذلك لا يجعل من هذه العلوم علوماً تابعة له، فهي محايدة كالمنطق في
علاقته بالفلسفة، وإن تمّ توظيف كل منهما لتحقيق مطالب النظامين، بل أن
الشواهد التاريخية تثبت بأن التوظيف كان في بعض الأحيان معكوساً، بمعنى أن
النظام المعياري وظّف المنطق لصالح قضاياه ضد النظام الوجودي، كما أن
الأخير وظّف بدوره اللغة العربية لإثبات مطالبه ضد الأول. وهذا يعني أن
كلاً من اللغة العربية والمنطق لا يحمل تصورات عقائدية أو وجودية خاصة، بل
هما صوريان يقبلان التطبيق على مختلف العلوم التي تناسبهما.
لذلك
فإن مناقضة البيانيين للمنطق ليس المقصود منه مناقضته لذاته، فهو في حد
ذاته لا يعارض البيان أو المعيار؛ بإعتباره صورياً، بل لأن الفلاسفة صاغوه
واستخدموه لأغراضهم «الوجودية» حتى أصبح ملاصقاً لأعمالهم الفلسفية، لذا
أبعده أهل المعيار عن إهتمامهم وحرّمه آخرون لهذا الغرض، حتى حان وقت إعادة
ترتيب إعتباره وتوظيفه داخل حيز البيان والنظام المعياري عموماً، كما فعل
إبن حزم والغزالي والفخر الرازي وغيرهم، وهو ما أشار إليه إبن خلدون في
مقدمته. فكما ذكر بأن «صناعة المنطق قبل إمام الحرمين الجويني لم تكن ظاهرة
في الملة، وما ظهر منها بعض الشيء لم يأخذ به المتكلمون لملابستها للعلوم
الفلسفية المباينة للعقائد الشرعية بالجملة، فكانت مهجورة عندهم لذلك»
(38). ونقل السيوطي في (الحاوي للفتاوي) آراء عدد من العلماء الذين حرموا
الاشتغال بالمنطق لكونه، كما يعتقد، يجر إلى الفلسفة والزندقة، فاعتبر أول
من نصّ على التحريم الشافعي، ومن أصحابه إمام الحرمين والغزالي في آخر
أمره، وإبن الصباغ صاحب (الشامل) وإبن القشيري ونصر المقدسي والعماد بن
يونس وحفده والسلفي وإبن بندار وإبن عساكر وإبن الأثير وإبن الصلاح وإبن
عبد السلام وأبو شامة والنووي وإبن دقيق العيد والبرهان الجعبري وأبو حيان
والشرف الدمياطي والذهبي والطيبي والملوي والأسنوي والأذرعي والولي العراقي
والشرف بن المقري وقاضي القضاة شرف الدين المناوي. ونصّ عليه من أئمة
المالكية إبن أبي زيد صاحب (الرسالة) والقاضي أبو بكر بن العربي وأبو بكر
الطرطوشي وأبو الوليد الباجي وأبو طالب المكي صاحب (قوت القلوب) وأبو الحسن
بن الحصار وأبو عامر بن الربيع وأبو الحسن بن حبيب وأبو حبيب المالقي وإبن
المنير وإبن رشد وإبن أبي جمرة وعامة أهل المغرب. ونصّ عليه من أئمة
الحنفية أبو سعيد السيرافي والسراج القزويني الذي ألّف في ذمّه كتاباً سماه
(نصيحة المسلم المشفق لمن ابتلى بحب علم المنطق). كما نصّ عليه من أئمة
الحنابلة إبن الجوزي وسعد الدين الحارثي وإبن تيمية الذي ألّف في ذمّه ونقض
قواعده مجلداً كبيراً سماه (نصيحة ذوي الإيمان في الرد على منطق اليونان)
(39).
لكن على رأي إبن خلدون فإنه منذ الجويني أخذت صناعة المنطق
طريقها وسط أهل الملة، ثم انتشرت وقرأها الناس وفرّقوها عن العلوم الفلسفية
من حيث أنها قانون ومعيار للأدلة فقط (40). ثم جاء الفخر الرازي فسبق غيره
في إعتبار المنطق علماً مستقلاً بذاته؛ وهو أنه آلة للعلوم (41).
أما
نظام الفلسفة والتصوف فحيث أنه يستند إلى إشكالية الوجود والحتمية، فإن
فهمه للخطاب لم يرتكز على نزعة «المعيار» كما هو الحال في النظام الأول، بل
قام على نزعة «الوجود» وإعتباراته الحتمية، إلى الحد الذي أصبح الخطاب
بحسب هذا الفهم مرآة لإظهار الوجود وحتميته حتى في القضايا المعيارية
الصميمة؛ بما فيها مسألة التكليف ذاتها. فطبقاً لهذا الفهم فإن عملية
التكليف التي يبديها الخطاب تتخذ طابعاً مجازياً حقيقته الوجود والحتمية.
وكتأكيد
على هذا المعنى نرى الفيلسوف الأرسطي إبن رشد يردّ مصدر التكليف الأمري
الإنشائي (المعياري) إلى تكليف (وجودي)، إذ اعتقد بأن لله أمراً «وجودياً»
حكم فيه على الفلك الذي يخصّه بالحركة وأمر سائر المبادئ المفارقة بأن تأمر
جميع الأفلاك الأخرى بالحركات، وهو الأمر الذي قامت عليه السماوات والأرض
«وهذا التكليف والطاعة هي الأصل في التكليف والطاعة التي وجبت على الإنسان
لكونه حيواناً ناطقاً» (42). وهو من منطلق هذا المعنى جعل عبادة الحكماء
وشريعتهم الخاصة «وجودية»، وذلك لأن خصوصية هذه العبادة والشريعة تتعلق -
عنده - بالفحص عن جميع الموجودات «إذ كان الخالق لا يُعبد بعبادة أشرف من
معرفة مصنوعاته التي تؤدي إلى معرفة ذاته سبحانه على الحقيقة، الذي هو أشرف
الأعمال عنده وأحظاها لديه» (43).
كما أن صدر المتألهين اعتبر
الرسالات السماوية للأنبياء داخلة في المعنى الوجودي الحتمي، متصوراً أن
فائدتها الوجودية جاءت تبعاً لما يفرضه القضاء الوجودي في سابق الأزل (44).
وهو من منطلق هذا المعنى فَهِمَ قضايا الخطاب المعيارية فهماً وجودياً
خالصاً، كما في تفسيره لآية ((قل كل يعمل على شاكلت