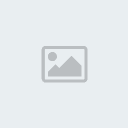المرحلة الأولى الحالة الراهنة في المدينة عند الهجرة: لم يكن معنى الهجرة
هو التخلص من الفتنة والاستهزاء فحسب، بل كانت الهجرة مع هذا تعاوناً على
إقامة مجتمع جديد في بلد آمن. ولذلك أصبح فرضاً على كل مسلم قادر أن يسهم
في بناء هذا الوطن الجديد، وأن يبذل جهده في تحصينه ورفعة شأنه.
ولا شك أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم هو الإمام والقائد والهادي في
بناء هذا المجتمع، وكانت إليه أزمة الأمور بلا نزاع. والأقوام التي كان
يواجهها رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في المدينة كانت على ثلاثة أصناف
يختلف أحوال كل واحد منها بالنسبة إلى الآخر اختلافاً واضحاً، وكان يواجه
بالنسبة إلى كل صنف منها مسائل عديدة غير المسائل التي كان يواجهها
بالنسبة إلى الأخرى. وهذه الأصناف الثلاثة هي: 1. أصحابه الصفوة الكرام
البررة رضي اللَّه عنهم. 2. المشركون الذين لم يؤمنوا بعد، وهم من صميم
قبائل المدينة. 3. اليهود. أ - أمّا المسائل التي كان يواجهها بالنسبة إلى
أصحابه فهي أن ظروف المدينة بالنسبة إليهم كانت تختلف تماماً عن الظروف
التي مروا بها في مكة، فهم في مكة وإن كانت تجمعهم كلمة جامعة، وكانوا
يستهدفون إلى أهداف متفقة، إلا أنهم كانوا متفرقين في بيوتات شتى، مقهورين
أذلاء مطرودين، لم يكن لهم من الأمر شيء، وإنما كان الأمر بيد أعدائهم في
الدين، فلم يكن هؤلاء المسلمون يستطيعون أن يقيموا مجتمعاً إسلامياً
جديداً بمواده التي لا يستغنى عنها أي مجتمع إنساني في العالم ولذلك نرى
السور المكية تقتصر على تفصيل المبادىء الإسلامية، وعلى التشريعات التي
يمكن العمل بها لكل فرد وحده، وعلى الحث على البر والخير ومكارم الأخلاق
والاجتناب عن الرذائل والدنايا. أما في المدينة فكان أمر المسلمين بأيديهم
منذ أول يوم، ولم يكن عليهم سيطرة أحد من الناس، فقد آن لهم أن يواجهوا
بمسائل الحضارة والعمران، وبمسائل المعيشة والاقتصاد، وبمسائل السياسة
والحكومة، وبمسائل السلم والحرب، وبالتنقيح الكامل في مسائل الحلال
والحرام والعبادة والأخلاق وما إلى ذلك من مسائل الحياة. كان قد آن لهم أن
يكونوا مجتمعاً جديداً، مجتمعاً إسلامياً، يختلف في جميع مراحل الحياة عن
المجتمع الجاهلي، ويمتاز عن أي مجتمع يوجد في العالم الإنساني، ويكون
ممثلاً للدعوة الإسلامية التي عانى لها المسلمون ألواناً من النكال
والعذاب طيلة عشر سنوات. ولا يخفى أن تكوين أي مجتمع على هذا النمط لا
يمكن أن يستتب في يوم واحد أو شهر واحد، أو سنة واحدة، بل لا بد له من زمن
طويل يتكامل فيه التشريع والتقنين مع التثقيف والتدريب والتربية تدريجياً،
وكان اللَّه كفيلاً بهذا التشريع، وكان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم
قائماً بتنفيذه، والإرشاد إليه، وتربية المسلمين وفقهه {هُوَ الَّذِي
بَعَثَ فِي الأُمِّيِّينَ رَسُولا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ
وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمْ الْكِتَابَ} [الجمعة: 2>. وكان الصحابة
رضي اللَّه عنهم مقبلين عليه بقلوبهم، يتحلون بأحكامه ويستبشرون بها
{وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آياتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًَا} [الأنفال:
2> وليس تفصيل هذه المسائل كلها من مباحث موضوعنا فنقتصر منها على قدر
الحاجة. كان هذا أعظم ما يواجهه رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بالنسبة
إلى المسلمين وهذا الذي كان هو المقصود - على نطاق واسع - من الدعوة
الإسلامية، والرسالة المحمدية، ولكن لم يكن هذا قضية طارئة. نعم كانت هناك
مسائل دون ذلك كانت تقتضي الاستعجال. كانت جماعة المسلمين مشتملة على
قسمين: قسم هُم في أرضهم وديارهم وأموالهم، لا يهمهم من ذلك إلا ما يهم
الرجل وهو آمن في سربه، وهم الأنصار، وكان بينهم تنافر مستحكم وعداء مزمن
منذ أمد بعيد. وكان بجانب هؤلاء قسم آخر وهم المهاجرون، فاتهم كل ذلك،
ونجوا بأنفسهم إلى المدينة، ليس لهم ملجأ يأوون إليه، ولا عمل يعملونه
لمعيشتهم، ولا مال يبلغون به قواماً من العيش، وكان عدد هؤلاء اللاجئين
غير قليل، وكانوا يزيدون يوماً فيوماً، فقد كان الإذنُ بالهجرة لكل من آمن
باللَّه ورسوله، ومعلوم أن المدينة لم تكن على ثروة طائلة، فتزعزع ميزانها
الاقتصادي، وفي هذه الساعة الحرجة قامت القوات المعادية للإسلام بشبه
مقاطعة اقتصادية قلت لأجلها المستوردات وتفاقمت الظروف. ب - أما الصنف
الثاني وهم المشركون من صميم قبائل المدينة، فلم تكن لهم سيطرة على
المسلمين، وكان منهم من تخالجه الشكوك ويتردد في ترك دين الآباء، ولكن لم
يكن يبطن العداوة والكيد ضد الإسلام والمسلمين، ولم تمض عليهم مدة طويلة
حتى أسلموا وأخلصوا دينهم للَّه. وكان فيهم من يبطن شديد الإحن والعداوة
ضد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم والمسلمين، ولكن لم يكن يستطيع أن
يناوئهم، بل كان مضطراً إلى إظهار الودّ والصفاء نظراً إلى الظروف، وعلى
رأس هؤلاء عبد اللَّه بن أُبي، فقد كانت الأوس والخزرج اجتمعوا على سيادته
بعد حرب بعاث، ولم يكونوا اجتمعوا على سيادة أحد قبله، وكانوا قد نظموا له
الخرز، ليتوجوه ويملكوه، وكان على وشك أن يصير ملكاً على أهل المدينة إذ
باغت مجيء رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ، وانصراف قومه عنه إليه، فكان
يرى أنه استلبه ملكاً، فكان يبطن شديد العداوة ضده، ولما رأى الظروف لا
تساعده على شركه، وأنه يحرم الفوائد الدنيوية أظهر الإسلام بعد بدر، ولكن
بقي مستبطناً الكفر، وكان لا يجد مجالاً للمكيدة برسول اللَّه صلى الله
عليه وسلم وبالمسلمين إلا ويأتي بها، وكان أصحابه من الرؤساء الذين حرموا
المناصب المرجوة في ملكه يساهمونه ويدعمونه في تنفيذ خططه، وربما كانوا
يتخذون بعض الأحداث، وضعاف العقول من المسلمين عملاء لهم، لتنفيذ خططهم. ج
- أما الصنف الثالث وهم اليهود فقد كانوا انحازوا إلى الحجاز زمن الاضطهاد
الأشوري والروماني كما أسلفنا، وكانوا في الحقيقة عبرانيين، ولكن بعد
الانسحاب إلى الحجاز صبغوا بالصبغة العربية في الزي واللغة والحضارة، حتى
صارت أسماء قبائلهم أو أفرادهم عربية، وحتى قامت بينهم وبين العرب علاقة
الزواج والمصاهرة، إلا أنهم تحفظوا بعصبيتهم الجنسية، ولم يندمجوا في
العرب قطعاً، بل كانوا يفتخرون بجنسيتهم الإسرائيلية - اليهودية - وكان
يحتقرون العرب احتقاراً بالغاً حتى كانوا يسمونهم أميين بمعنى أنهم وحوش
سذج، وأراذل متأخرين، وكانوا يرون أن أموال العرب مباحة لهم، يأكلونها كيف
شاؤوا، {قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ} [آل عمران:
75> ولم يكن لهم تحمس في نشر دينهم وإنما
جل بضاعتهم الدينية هي الفأل والسحر والنفث والرقية وأمثالها، وبذلك كانوا
يرون أنفسهم أصحاب علم وفضل وقيادة روحانية. وكانوا مهرة في فنون الكسب
والمعيشة، فكانت في أيديهم تجارة الحبوب والتمر والخمر والثياب، كانوا
يوردون الثياب والحبوب والخمر، ويصدرون التمر، وكانت لهم أعمال من دون ذلك
هم لها عاملون، فكانوا يأخذون المنافع من عامة العرب أضعافاً مضاعفة، ثم
لم يكونوا يقتصرون على ذلك، بل كانوا أكالين للربا، كانوا يقرضون شيوخ
العرب وساداتهم، ليكتسب هؤلاء الرؤساء مدائح من الشعراء، وسمعة بين الناس
بعد إنفاقها من غير جدوى ولا طائلة، ثم كانوا يرتهنون أرض هؤلاء الرؤساء
وزروعهم وحوائطهم، ثم لا يلبثون إلا أعواماً حتى يتملكونها. وكانوا أصحاب
دسائس ومؤامرات وعتو وفساد، يلقون العداوة والشحناء بين القبائل العربية
المجاورة، ويغرون بعضها على بعض بكيد خفي لم تكن تشعره تلك القبائل، فلا
تزال في حروب دامية متواصلة، ولا تزال أنامل اليهود تؤجج نيرانها كلما
رأتها تقارب الخمود والانطفاء، وبعد هذا التحريض والإغراء، كانوا يقعدون
على جانب، يرون ساكتين ما يحل بهؤلاء العرب، نعم كانوا يزودونهم بقروض
ثقيلة ربوية حتى لا يحجموا عن الحرب لعسر النفقة. وبهذا العمل كانوا
يحصلون على منفعتين، كانوا يتحفظون على كيانهم اليهودي، وينفقون سوق
الربا؛ ليأكلوه أضعافاً مضاعفة، ويكسبوا ثروات طائلة. وكانت في يثرب منهم
ثلاث قبائل مشهورة: 1. بنو قينقاع، كانوا حلفاء الخزرج، وكانت ديارهم داخل
المدينة. 2. بنو النضير. 3. بنو قريظة، وهاتان القبيلتان كانتا حلفاء
الأوس، وكانت ديارهما بضواحي المدينة. وهذه القبائل هي التي كانت تثير
الحروب بين الأوس والخزرج منذ أمد بعيد وقد ساهمت بأنفسها في حرب بعاث، كل
مع حلفائها. وطبعاً فإن اليهود لم يكن يرجى منهم أن ينظروا إلى الإسلام
إلا بعين البغض والحقد، فالرسول لم يكن منهم حتى يتمكن من إسكان جأش
عصبيتهم الجنسية التي كانت متغلبة على نفسياتهم وعقليتهم، ثم إنّ دعوة
الإسلام لم تكن إلا دعوة صالحة تؤلف بين أشتات القلوب، وتطفىء نار العداوة
والبغضاء، وتدعو إلى التزام الأمانة في الشؤون، وإلى التقيد بأكل الحلال
من طيب الأموال، ومعنى كل ذلك أن قبائل يثرب العربية ستتألف فيما بينها،
وحينئذ لا بد من أن تفلت من براثن اليهود، فيفشل نشاطهم التجاري، ويحرموا
أموال الربا التي كانت تدور عليه رحى ثروتهم بل ربما يحتمل أن تتيقظ تلك
القبائل، فتدخل في حسابها الأموال الربوية التي أخذها اليهود، فتقوم
بإرجاع أرضها وحوائطها التي أضاعتها إلى اليهود في تأدية الربا. كان
اليهود يدخلون كل ذلك في حسابهم منذ عرفوا أن دعوة الإسلام تحاول
الاستقرار في يثرب، ولذلك كانوا يبطنون العداوة ضد الإسلام، وضد رسول
اللَّه صلى الله عليه وسلم منذ أن دخل يثرب، وإن كانوا لم يتجاسروا على
إظهارها إلا بعد حين. ويظهر ذلك جلياً بما رواه ابن إسحاق عن أم المؤمنين
صفية رضي اللَّه عنها. قال ابن إسحاق حدثت عن صفية بنت حيي بن أخطب أنها
قالت: كنت أحب ولد أبي إليه، وإلى عمي أبي ياسر، لم ألقهما قط مع ولد لهما
إلا أخذاني دونه قالت: فلما قدم رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم المدينة،
ونزل قباء في بني عمرو بن عوف، غدا عليه أبي حيي بن أخطب، وعمي أبو ياسر
بن أخطب، مغلسين، قالت: فلم يرجعا حتى كانا مع غروب الشمس، قالت: فأتيا
كالين كسلانين ساقطين يمشيان الهوينى. قالت: فهششت إليهما كما كنت أصنع،
فواللَّه ما التفت إلى واحد منهما، مع ما بهما من الغم. قالت: وسمعت عمي
أبا ياسر وهو يقول لأبي حيي بن أخطب أهو هو؟ قال: نعم واللَّه، قال:
أتعرفه وتثبته؟قال: نعم، قال: فما في نفسك منه؟ قال: عداوته واللَّه ما
بقيت. ويشهد بذلك أيضاً ما رواه البخاري في إسلام عبد اللَّه بن سلام رضي
اللَّه عنه، فقد كان حبراً من فطاحل علماء اليهود، ولما سمع بمقدم رسول
اللَّه صلى الله عليه وسلم المدينة في بني النجار جاءه مستعجلاً، وألقى
إليه أسئلة لا يعلمها إلا نبي ولما سمع ردوده صلى الله عليه وسلم عليها
آمن به ساعته ومكانه، ثم قال له: إن اليهود قوم بهت، إن علموا بإسلامي قبل
أن تسألهم بهتوني عندك، فأرسل رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فجاءت
اليهود، ودخل عبد اللَّه بن سلام البيت. فقال رسول اللَّه صلى الله عليه
وسلم أي رجل فيكم عبد اللَّه سلام؟ قالوا: أعلمنا وابن أعلمنا، وأخيرنا
وابن أخيرنا وفي لفظ: سيدنا وابن سيدنا، وفي لفظ آخر: خيرنا وابن خيرنا
وأفضلنا وابن أفضلنا، فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أفرأيتم إن
أسلم عبد اللَّه؟ فقالوا: أعاذه اللَّه من ذلك مرتين أو ثلاثاً فخرج إليهم
عبد اللَّه فقال: أشهد أن لا إله إلا اللَّه وأشهد أن محمداً رسول اللَّه
فقالوا: شرنا وابن شرنا، ووقعوا فيه. وفي لفظ فقال: يا معشر اليهود اتقوا
اللَّه، فواللَّه الذي لا إله إلا هو إنكم لتعلمون أنه رسول اللَّه، وأنه
جاء بحق فقالوا: كذبت. وهذه أول تجربة تلقاها رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم
من اليهود، في أول يوم دخل فيه المدينة. هذا كله من حيث الداخلية، وأما من
حيث الخارجية فإن ألد قوة ضد الإسلام هي قريش، كانت قد جربت منذ عشرة
أعوام، حينما كان المسلمون تحت يديها، كل أساليب الإرهاب والتهديد
والمضايقة وسياسة التجويع والمقاطعة، وأذاقتهم التنكيلات والويلات، وشنت
عليهم حرباً نفسية مضنية مع دعاية واسعة منظمة، ثم لما هاجر المسلمون إلى
المدينة صادرت أرضهم وديارهم وأموالهم، وحالت بينهم وبين أزواجهم
وذرياتهم، بل حبست وعذبت من قدرت عليه، ثم لم تقتصر على هذا بل تآمرت على
الفتك بصاحب الدعوة صلى الله عليه وسلم والقضاء عليه، وعلى دعوته، ولم تأل
جهداً في تنفيذ هذه المؤامرة. وبعد هذا كله، لما نجا المسلمون إلى أرض
تبعد عنها خمسمائة كيلومتراً. قامت بدورها السياسي لما لها من الصدارة
الدنيوية والزعامة الدينية بين أوساط العرب بصفتها ساكنة الحرم ومجاورة
بيت اللَّه وسدنته، فأغرت غيرها من مشركي الجزيرة ضد أهل المدينة، حتى
صارت المدينة في شبه مقاطعة شديدة قلت مستورداتها في حين كان عدد اللاجئين
يزيد يوماً فيوماً، إن حالة الحرب قائمة يقيناً بين هؤلاء الطغاة من أهل
مكة وبين المسلمين في وطنهم الجديد، ومن السفه تحميل المسلمين أوزار هذا
الخصام. كان حقاً للمسلمين أن يصادروا أموال هؤلاء الطغاة كما صودرت
أموالهم، وأن يدالوا عليهم من التنكيلات بمثل ما أدالوا بها، وأن يقيموا
في سبيل حياتهم العراقيل كما أقاموها في سبيل حياة المسلمين، وأن يكال
لهؤلاء الطغاة صاعاً بصاع حتى لا يجدوا سبيلاً لإبادة المسلمين، واستئصال
خضرائهم. هذه هي القضايا والمشاكل التي كان يواجهها رسول اللَّه صلى الله
عليه وسلم حين ورد المدينة بصفته رسولاً هادياً وإماماً قائداً. وقد قام
رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بدور الرسالة والقيادة في المدينة، وأدلى
إلى كل قوم بما كانوا يستحقونه من الرأفة والرحمة أو الشدة والنكال، ولا
شك أن الرحمة كانت غالبة على الشدة والعنت، حتى عاد الأمر إلى الإسلام
وأهله في بضع سنوات، وسيجد القارىء كل ذلك جلياً في الصفحات الآتية بناء
مجتمع جديد: قد أسلفنا أن نزول رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بالمدينة
في بني النجار كان يوم الجمعة - ربيع الأول سنة ه الموافق - سبتمبر سنة -
م، وأنه نزل في أرض أمام دار أبي أيوب، وقال: ههنا المنزل إن شاء اللَّه،
ثم انتقل إلى بيت أبي أيوب. بناء المسجد النبوي: وأول خطوة خطاها رسول
اللَّه صلى الله عليه وسلم بعد ذلك هو إقامة المسجد النبوي. ففي المكان
الذي بركت فيه ناقته أمر ببناء هذا المسجد، واشتراه من غلامين يتيمين كان
يملكانه، وساهم في بنائه بنفسه، كان ينقل اللبن والحجارة ويقول: اللهم لا
عيش إلا عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة وكان يقول: هذا الحمال لا
حمال خيبر هذا أبرّ ربن ا وأطهر وكان ذلك مما يزيد نشاط الصحابة في البناء
حتى إن أحدهم ليقول: لئن قعدنا والنبي يعمل لذاك منا العمل المضلل وكانت
في ذلك المكان قبور المشركين، وكان فيه خرب ونخل وشجرة من غرقد، فأمر رسول
اللَّه صلى الله عليه وسلم بقبور المشركين فنبشت، وبالخرب فسويت، وبالنخل
والشجرة فقطعت، وصفت في قبلة المسجد، وكانت القبلة إلى بيت المقدس، وجعلت
عضادتاه من حجارة، وأقيمت حيطانه من اللبن والطين، وجعل سقفه من جريد
النخل، وعمده الجذوع، وفرشت أرضه من الرمال والحصباء، وجعلت له ثلاثة
أبواب، وطوله مما يلي القبلة إلى مؤخره مائة ذراع، والجانبان مثل ذلك أو
دونه، وكان أساسه قريباً من ثلاثة أذرع. وبنى بيوتاً إلى جانبه، بيوت
الحجر باللبن وسقفها بالجريد والجذوع، وهي حجرات أزواجه صلى الله عليه
وسلم ، وبعد تكامل الحجرات انتقل إليها من بيت أبي أيوب. ولم يكن المسجد
موضعاً لأداء الصلوات فحسب، بل كان جامعة يتلقى فيها المسلمون تعاليم
الإسلام وتوجيهاته، ومنتدى تلتقي وتتآلف فيه العناصر القبلية المختلفة
التي طالما نافرت بينها النزعات الجاهلية وحروبها، وقاعدة لإدارة جميع
الشؤون وبث الانطلاقات، وبرلماناً لعقد المجالس الاستشارية والتنفيذية.
وكان مع هذا كله داراً يسكن فيها عدد كبير من فقراء المهاجرين اللاجئين
الذين لم يكن لهم هناك دار ولا مال ولا أهل ولا بنون. وفي أوائل الهجرة
شرع الأذان، النغمة العلوية التي تدوي في الآفاق، كل يوم خمس مرات، والتي
ترتج لها أنحاء عالم الوجود. وقصة رؤيا عبد اللَّه بن زيد بن عبد ربه بهذا
الصدد معروفة، رواها الترمذي وأبو داود وأحمد وابن خزيمة. المؤاخاة بين
المسلمين: وكما قام النبي صلى الله عليه وسلم ببناء المسجد مركز التجمع
والتآلف. قام بعمل آخر من أروع ما يأثره التاريخ، وهو المؤاخاة بين
المهاجرين الأنصار، قال ابن القيم ثم آخى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم
بين المهاجرين الأنصار، في دار أنس بن مالك، وكانوا تسعين رجلاً، نصفهم من
المهاجرين، ونصفهم من الأنصار، آخى بينهم على المواساة، ويتوارثون بعد
الموت دون ذوي الأرحام، إلى حين وقعة بدر، فلما أنزل اللَّه عز وجل:
{وَأُوْلُوا الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ} [الأنفال: 75>،
الأنفال - رد التوارث، دون عقد الأخوة. وقد قيل إنه آخى بين المهاجرين
بعضهم مع بعض مؤاخاة ثانية. والثبت الأول، والمهاجرين كانوا مستغنين بأخوة
الإسلام وأخوة الدار وقرابة النسب عن عقد مؤاخاة بخلاف المهاجرين مع
الأنصار ا هـ. ومعنى هذا الإخاء كما قال محمد الغزالي أن تذوب عصبيات
الجاهلية فلا حمية إلا للإسلام، وأن تسقط فوارق النسب واللون والوطن، فلا
يتقدم أحد أو يتأخر إلا بمروءته وتقواه. وقد جعل الرسول صلى الله عليه
وسلم هذه الأخوة عقداً نافذاً لا لفظاً فارغاً وعملاً يرتبط بالدماء
والأموال، لا تحية تثرثر بها الألسنة ولا يقوم لها أثر. وكانت عواطف
الإيثار والمواساة والمؤانسة تمتزج في هذه الأخوة، وتملأ المجتمع الجديد
بأروع الأمثال. فقد روى البخاري أنهم لما قدموا المدينة آخى رسول اللَّه
صلى الله عليه وسلم بين عبد الرحمن وسعد بن الربيع، فقال لعبد الرحمن إني
أكثر الأنصار مالاً، فاقسم مالي نصفين، ولي امرأتان، فانظر أعجبهما إليك
فسمها لي، أطلقها، فإذا انقضت عدتها فتزوجها، قال: بارك اللَّه لك في أهلك
ومالك، وأين سوقكم؟ فدلوه على سوق بني قينقاع، فما انقلب إلا ومعه فضل من
أقط وسمن، ثم تابع الغدو، ثم جاء يوماً وبه أثر صفرة، فقال النبي صلى الله
عليه وسلم مهيم؟ قال: تزوجت. قال: كم سقت إليها؟ قال: نواة من ذنب. وروى
عن أبي هريرة قال: قالت الأنصار للنبي صلى الله عليه وسلم اقسم بيننا وبين
إخواننا النخيل. قال: لا. فقالوا: فتكفونا المؤنة ونشرككم في الثمرة قالوا
سمعنا وأطعنا. وهذا يدلنا على ما كان عليه الأنصار من الحفاوة البالغة
بإخوانهم المهاجرين، ومن التضحية والإيثار والود والصفاء، وما كان عليه
المهاجرون من تقدير هذا الكرم حق قدره فلم يستغلوه ولم ينالوا منه إلا
بقدر ما يقيم أودهم. وحقاً فقد كانت هذه المؤاخاة حكمة فذة، وسياسة صائبة
حكيمة، وحلاً رائعاً لكثير من المشاكل التي كان يواجهها المسلمون، والتي
أشرنا إليها. ميثاق التحالف الإسلامي: وكما قام رسول اللَّه صلى الله عليه
وسلم بعقد المؤاخاة بين المؤمنين، قام بعقد معاهدة أزاح بها كل ما كان من
حزازات الجاهلية، والنزعات القبلية، ولمن يترك مجالاً لتقاليد الجاهلية،
وهاك بنودها ملخصاً: هذا كتاب من محمد النبي صلى الله عليه وسلم بين
المؤمنين والمسلمين من قريش ويثرب ومن تبعهم فلحق بهم، وجاهد معهم أنهم
أمة واحدة من دون الناس. المهاجرون من قريش على ربعتهم يتعاقلون بينهم،
وهم يفدون عانيهم بالمعروف والقسط بين المؤمنين، وكل قبيلة من الأنصار على
ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى، وكل طائفة منهم تفدى عانيها بالمعروف
والقسط بين المؤمنين. وأن المؤمنين لا يتركون مفرحاً بينهم أن يعطوه
بالمعروف في فداء أو عقل. وأن المؤمنين المتقين على من بغى عليهم، أو
ابتغى دسيعة ظلم أو إثم أو عدوان أو فساد بين المؤمنين. وأن أيديهم عليه
جميعاً، ولو كان ولد أحدهم. ولا يقتل مؤمن مؤمناً في كافر. ولا ينصر
كافراً على مؤمن. وان ذمة المسلمين واحدة يجير عليهم أدناهم. وأن من تبعنا
من يهود فإن له النصر والأسوة غير مظلومين ولا متناصرين عليهم. وأن سلم
المؤمنين واحدة لا يسالم مؤمن دون مؤمن في قتال في سبيل اللَّه إلا على
سواء وعدا بينهم. وأن المؤمنين يبيء بعضهم على بعض بما نال دماءهم في سبيل
اللَّه. وأنه لا يجير مشرك مالاً لقريش ولا نفساً، ولا يحول دونه على
مؤمن. وأنه من اعتبط مؤمناً قتلا عن بينة فإنه قود به، إلا أن يرضى ولي
المقتول. وأن المؤمنين عليه كافة ولا يحل لهم إلا قيام عليه. وأنه لا يحل
لمؤمن أن ينصر محدثاً ولا يؤويه، وأنه من نصره أو آواه فإن عليه لعنة
اللَّه وغضبه يوم القيامة، ولا يؤخذ منه صرف ولا عدل. وأنكم مهما اختلفتم
فيه من شيء فإن مرده إلى اللَّه عز وجل وإلى محمد صلى الله عليه وسلم. أثر
المعنويات في المجتمع: بهذه الحكمة، وبهذا الحذاقة أرسى رسول اللَّه صلى
الله عليه وسلم قواعد مجتمع جديد، ولكن كانت هذه الظاهرة أثراً للمعاني
التي كان يتمتع بها أولئك الأمجاد بفضل صحبة النبي صلى الله عليه وسلم ،
وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعهدهم بالتعليم والتربية وتزكية النفوس
والحث على مكارم الأخلاق، ويؤدبهم بآداب الود والإخاء والمجد والشرف
والعبادة والطاعة. سأله رجل: أيّ الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام، وتقرىء
السلام على من عرفت ومن لم تعرف. قال عبد اللَّه بن سلام: لما قدم النبي
صلى الله عليه وسلم المدينة جئت فلما تبينت وجهه، عرفت أن وجهه ليس بوجه
كذاب، فكان أول ما قال: "يا أيها الناس أفشوا السلام، وأطعموا الطعام،
وصلوا الأرحام، وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام". وكان يقول
"لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه". ويقول: "المسلم من سلم المسلمون
من لسانه ويده". ويقول: "لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه".
ويقول: "المؤمنون كرجل واحد، إن اشتكى عينه اشتكى كله، وإن اشتكى رأسه
اشتكى كله". ويقول: "المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً". ويقول: "لا
تباغضوا، ولا تحاسدوا، ولا تدابروا، وكونوا عباد اللَّه إخواناً ولا يحل
لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام". ويقول: "المسلم أخو المسلم لا يظلمه
ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان اللَّه في حاجته، ومن فرج عن مسلم
كربة فرج اللَّه عنه كربة من كربات يوم القيامة، ومن ستر مسلماً ستره
اللَّه يوم القيامة". ويقول: "ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء".
ويقول: "ليس المؤمن بالذي يشبع وجاره جائع إلى جانبه". ويقول: "سباب
المؤمن فسوق، وقتاله كفر". وكان يجعل إماطة الأذى عن الطريق صدقة، وبعدها
شعبة من شعب الإيمان. وكان يحثهم على الإنفاق، ويذكر من فضائله ما تتقاذف
إليه القلوب، فكان يقول: "الصدقة تطفىء الخطايا كما يطفىء الماء النار.
ويقول: "أيما مسلم كسا مسلماً ثوباً على عري، كساه اللَّه من خضر الجنة،
وأيما مسلم أطعم مسلماً على جوع أطعمه اللَّه من ثمار الجنة، وأيما مسلم
سقا مسلماً على ظمأ سقاه اللَّه من الرحيق المختوم". ويقول: "اتقوا النار
ولو بشق تمرة، فإن لم تجد فبكلمة طيبة". وبجانب هذا كان يحث حثاً شديداً
على الاستعفاف عن المسألة، ويذكر فضائل الصبر والقناعة، كان يعد المسألة
كدوحاً أو خدوشاً أو خموشاً في وجه السائل. اللهم إلا إذا كان مضطراً، كما
كان يحدث لهم بما في العبادات من الفضائل والأجر والثواب عند اللَّه، وكان
يربطهم بالوحي النازل عليه من السماء ربطاً موثقاً يقرؤه عليهم، ويقرؤونه،
لتكون هذه الدراسة إشعاراً بما عليهم من حقوق الدعوة، وتبعات الرسالة،
فضلاً عن ضرورة الفهم والتدبر. وهكذا رفع معنوياتهم ومواهبهم، وزودهم
بأعلى القيم والأقدار والمثل، حتى صاروا صورة لأعلى قمة من الكمال عرفت في
تاريخ البشر بعد الأنبياء. يقول عبد اللَّه بن مسعود رضي اللَّه عنه من
كان مستناً فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة اولئك أصحاب
محمد صلى الله عليه وسلم ، كانوا أفضل هذه الأمة، أبرها قلوباً، وأعمقها
علماً، وأقلها تكلفاً، اختارهم اللَّه لصحبة نبيه ولإقامة دينه، فاعرفوا
لهم فضلهم، واتبعوهم على أثرهم، وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم وسيرهم،
فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. ثم إن هذا الرسول القائد الأعظم صلى الله
عليه وسلم كان يتمتع من الصفات المعنوية والظاهرة ومن الكمالات والمواهب
والأمجاد والفضائل ومكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال بما جعلته تهوي إليه
الأفئدة، وتتفانى عليه النفوس، فما يتكلم بكلمة إلا ويبادر صحابته رضي
اللَّه عنه إلى امتثالها، وما يأتي برشد وتوجيه إلا ويتسابقون إلى التحلي
به. بمثل هذا استطاع صلى الله عليه وسلم أن يبني في المدينة مجتمعاً
جديداً أروع وأشرف مجتمع عرفه التاريخ، وأن يضع لمشاكل هذا المجتمع حلاً
تتنفس له الإنسانية الصعداء، بعد أن كانت تعبت في غياهب الزمان ودياجير
الظلمات. وبمثل هذه المعنويات الشامخة تكاملت عناصر المجتمع الجديد الذي
واجه كل تيارات الزمان حتى صرف وجهتها، وحول مجرى التاريخ والأيام.
هو التخلص من الفتنة والاستهزاء فحسب، بل كانت الهجرة مع هذا تعاوناً على
إقامة مجتمع جديد في بلد آمن. ولذلك أصبح فرضاً على كل مسلم قادر أن يسهم
في بناء هذا الوطن الجديد، وأن يبذل جهده في تحصينه ورفعة شأنه.
ولا شك أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم هو الإمام والقائد والهادي في
بناء هذا المجتمع، وكانت إليه أزمة الأمور بلا نزاع. والأقوام التي كان
يواجهها رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في المدينة كانت على ثلاثة أصناف
يختلف أحوال كل واحد منها بالنسبة إلى الآخر اختلافاً واضحاً، وكان يواجه
بالنسبة إلى كل صنف منها مسائل عديدة غير المسائل التي كان يواجهها
بالنسبة إلى الأخرى. وهذه الأصناف الثلاثة هي: 1. أصحابه الصفوة الكرام
البررة رضي اللَّه عنهم. 2. المشركون الذين لم يؤمنوا بعد، وهم من صميم
قبائل المدينة. 3. اليهود. أ - أمّا المسائل التي كان يواجهها بالنسبة إلى
أصحابه فهي أن ظروف المدينة بالنسبة إليهم كانت تختلف تماماً عن الظروف
التي مروا بها في مكة، فهم في مكة وإن كانت تجمعهم كلمة جامعة، وكانوا
يستهدفون إلى أهداف متفقة، إلا أنهم كانوا متفرقين في بيوتات شتى، مقهورين
أذلاء مطرودين، لم يكن لهم من الأمر شيء، وإنما كان الأمر بيد أعدائهم في
الدين، فلم يكن هؤلاء المسلمون يستطيعون أن يقيموا مجتمعاً إسلامياً
جديداً بمواده التي لا يستغنى عنها أي مجتمع إنساني في العالم ولذلك نرى
السور المكية تقتصر على تفصيل المبادىء الإسلامية، وعلى التشريعات التي
يمكن العمل بها لكل فرد وحده، وعلى الحث على البر والخير ومكارم الأخلاق
والاجتناب عن الرذائل والدنايا. أما في المدينة فكان أمر المسلمين بأيديهم
منذ أول يوم، ولم يكن عليهم سيطرة أحد من الناس، فقد آن لهم أن يواجهوا
بمسائل الحضارة والعمران، وبمسائل المعيشة والاقتصاد، وبمسائل السياسة
والحكومة، وبمسائل السلم والحرب، وبالتنقيح الكامل في مسائل الحلال
والحرام والعبادة والأخلاق وما إلى ذلك من مسائل الحياة. كان قد آن لهم أن
يكونوا مجتمعاً جديداً، مجتمعاً إسلامياً، يختلف في جميع مراحل الحياة عن
المجتمع الجاهلي، ويمتاز عن أي مجتمع يوجد في العالم الإنساني، ويكون
ممثلاً للدعوة الإسلامية التي عانى لها المسلمون ألواناً من النكال
والعذاب طيلة عشر سنوات. ولا يخفى أن تكوين أي مجتمع على هذا النمط لا
يمكن أن يستتب في يوم واحد أو شهر واحد، أو سنة واحدة، بل لا بد له من زمن
طويل يتكامل فيه التشريع والتقنين مع التثقيف والتدريب والتربية تدريجياً،
وكان اللَّه كفيلاً بهذا التشريع، وكان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم
قائماً بتنفيذه، والإرشاد إليه، وتربية المسلمين وفقهه {هُوَ الَّذِي
بَعَثَ فِي الأُمِّيِّينَ رَسُولا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ
وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمْ الْكِتَابَ} [الجمعة: 2>. وكان الصحابة
رضي اللَّه عنهم مقبلين عليه بقلوبهم، يتحلون بأحكامه ويستبشرون بها
{وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آياتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًَا} [الأنفال:
2> وليس تفصيل هذه المسائل كلها من مباحث موضوعنا فنقتصر منها على قدر
الحاجة. كان هذا أعظم ما يواجهه رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بالنسبة
إلى المسلمين وهذا الذي كان هو المقصود - على نطاق واسع - من الدعوة
الإسلامية، والرسالة المحمدية، ولكن لم يكن هذا قضية طارئة. نعم كانت هناك
مسائل دون ذلك كانت تقتضي الاستعجال. كانت جماعة المسلمين مشتملة على
قسمين: قسم هُم في أرضهم وديارهم وأموالهم، لا يهمهم من ذلك إلا ما يهم
الرجل وهو آمن في سربه، وهم الأنصار، وكان بينهم تنافر مستحكم وعداء مزمن
منذ أمد بعيد. وكان بجانب هؤلاء قسم آخر وهم المهاجرون، فاتهم كل ذلك،
ونجوا بأنفسهم إلى المدينة، ليس لهم ملجأ يأوون إليه، ولا عمل يعملونه
لمعيشتهم، ولا مال يبلغون به قواماً من العيش، وكان عدد هؤلاء اللاجئين
غير قليل، وكانوا يزيدون يوماً فيوماً، فقد كان الإذنُ بالهجرة لكل من آمن
باللَّه ورسوله، ومعلوم أن المدينة لم تكن على ثروة طائلة، فتزعزع ميزانها
الاقتصادي، وفي هذه الساعة الحرجة قامت القوات المعادية للإسلام بشبه
مقاطعة اقتصادية قلت لأجلها المستوردات وتفاقمت الظروف. ب - أما الصنف
الثاني وهم المشركون من صميم قبائل المدينة، فلم تكن لهم سيطرة على
المسلمين، وكان منهم من تخالجه الشكوك ويتردد في ترك دين الآباء، ولكن لم
يكن يبطن العداوة والكيد ضد الإسلام والمسلمين، ولم تمض عليهم مدة طويلة
حتى أسلموا وأخلصوا دينهم للَّه. وكان فيهم من يبطن شديد الإحن والعداوة
ضد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم والمسلمين، ولكن لم يكن يستطيع أن
يناوئهم، بل كان مضطراً إلى إظهار الودّ والصفاء نظراً إلى الظروف، وعلى
رأس هؤلاء عبد اللَّه بن أُبي، فقد كانت الأوس والخزرج اجتمعوا على سيادته
بعد حرب بعاث، ولم يكونوا اجتمعوا على سيادة أحد قبله، وكانوا قد نظموا له
الخرز، ليتوجوه ويملكوه، وكان على وشك أن يصير ملكاً على أهل المدينة إذ
باغت مجيء رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ، وانصراف قومه عنه إليه، فكان
يرى أنه استلبه ملكاً، فكان يبطن شديد العداوة ضده، ولما رأى الظروف لا
تساعده على شركه، وأنه يحرم الفوائد الدنيوية أظهر الإسلام بعد بدر، ولكن
بقي مستبطناً الكفر، وكان لا يجد مجالاً للمكيدة برسول اللَّه صلى الله
عليه وسلم وبالمسلمين إلا ويأتي بها، وكان أصحابه من الرؤساء الذين حرموا
المناصب المرجوة في ملكه يساهمونه ويدعمونه في تنفيذ خططه، وربما كانوا
يتخذون بعض الأحداث، وضعاف العقول من المسلمين عملاء لهم، لتنفيذ خططهم. ج
- أما الصنف الثالث وهم اليهود فقد كانوا انحازوا إلى الحجاز زمن الاضطهاد
الأشوري والروماني كما أسلفنا، وكانوا في الحقيقة عبرانيين، ولكن بعد
الانسحاب إلى الحجاز صبغوا بالصبغة العربية في الزي واللغة والحضارة، حتى
صارت أسماء قبائلهم أو أفرادهم عربية، وحتى قامت بينهم وبين العرب علاقة
الزواج والمصاهرة، إلا أنهم تحفظوا بعصبيتهم الجنسية، ولم يندمجوا في
العرب قطعاً، بل كانوا يفتخرون بجنسيتهم الإسرائيلية - اليهودية - وكان
يحتقرون العرب احتقاراً بالغاً حتى كانوا يسمونهم أميين بمعنى أنهم وحوش
سذج، وأراذل متأخرين، وكانوا يرون أن أموال العرب مباحة لهم، يأكلونها كيف
شاؤوا، {قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ} [آل عمران:
75> ولم يكن لهم تحمس في نشر دينهم وإنما
جل بضاعتهم الدينية هي الفأل والسحر والنفث والرقية وأمثالها، وبذلك كانوا
يرون أنفسهم أصحاب علم وفضل وقيادة روحانية. وكانوا مهرة في فنون الكسب
والمعيشة، فكانت في أيديهم تجارة الحبوب والتمر والخمر والثياب، كانوا
يوردون الثياب والحبوب والخمر، ويصدرون التمر، وكانت لهم أعمال من دون ذلك
هم لها عاملون، فكانوا يأخذون المنافع من عامة العرب أضعافاً مضاعفة، ثم
لم يكونوا يقتصرون على ذلك، بل كانوا أكالين للربا، كانوا يقرضون شيوخ
العرب وساداتهم، ليكتسب هؤلاء الرؤساء مدائح من الشعراء، وسمعة بين الناس
بعد إنفاقها من غير جدوى ولا طائلة، ثم كانوا يرتهنون أرض هؤلاء الرؤساء
وزروعهم وحوائطهم، ثم لا يلبثون إلا أعواماً حتى يتملكونها. وكانوا أصحاب
دسائس ومؤامرات وعتو وفساد، يلقون العداوة والشحناء بين القبائل العربية
المجاورة، ويغرون بعضها على بعض بكيد خفي لم تكن تشعره تلك القبائل، فلا
تزال في حروب دامية متواصلة، ولا تزال أنامل اليهود تؤجج نيرانها كلما
رأتها تقارب الخمود والانطفاء، وبعد هذا التحريض والإغراء، كانوا يقعدون
على جانب، يرون ساكتين ما يحل بهؤلاء العرب، نعم كانوا يزودونهم بقروض
ثقيلة ربوية حتى لا يحجموا عن الحرب لعسر النفقة. وبهذا العمل كانوا
يحصلون على منفعتين، كانوا يتحفظون على كيانهم اليهودي، وينفقون سوق
الربا؛ ليأكلوه أضعافاً مضاعفة، ويكسبوا ثروات طائلة. وكانت في يثرب منهم
ثلاث قبائل مشهورة: 1. بنو قينقاع، كانوا حلفاء الخزرج، وكانت ديارهم داخل
المدينة. 2. بنو النضير. 3. بنو قريظة، وهاتان القبيلتان كانتا حلفاء
الأوس، وكانت ديارهما بضواحي المدينة. وهذه القبائل هي التي كانت تثير
الحروب بين الأوس والخزرج منذ أمد بعيد وقد ساهمت بأنفسها في حرب بعاث، كل
مع حلفائها. وطبعاً فإن اليهود لم يكن يرجى منهم أن ينظروا إلى الإسلام
إلا بعين البغض والحقد، فالرسول لم يكن منهم حتى يتمكن من إسكان جأش
عصبيتهم الجنسية التي كانت متغلبة على نفسياتهم وعقليتهم، ثم إنّ دعوة
الإسلام لم تكن إلا دعوة صالحة تؤلف بين أشتات القلوب، وتطفىء نار العداوة
والبغضاء، وتدعو إلى التزام الأمانة في الشؤون، وإلى التقيد بأكل الحلال
من طيب الأموال، ومعنى كل ذلك أن قبائل يثرب العربية ستتألف فيما بينها،
وحينئذ لا بد من أن تفلت من براثن اليهود، فيفشل نشاطهم التجاري، ويحرموا
أموال الربا التي كانت تدور عليه رحى ثروتهم بل ربما يحتمل أن تتيقظ تلك
القبائل، فتدخل في حسابها الأموال الربوية التي أخذها اليهود، فتقوم
بإرجاع أرضها وحوائطها التي أضاعتها إلى اليهود في تأدية الربا. كان
اليهود يدخلون كل ذلك في حسابهم منذ عرفوا أن دعوة الإسلام تحاول
الاستقرار في يثرب، ولذلك كانوا يبطنون العداوة ضد الإسلام، وضد رسول
اللَّه صلى الله عليه وسلم منذ أن دخل يثرب، وإن كانوا لم يتجاسروا على
إظهارها إلا بعد حين. ويظهر ذلك جلياً بما رواه ابن إسحاق عن أم المؤمنين
صفية رضي اللَّه عنها. قال ابن إسحاق حدثت عن صفية بنت حيي بن أخطب أنها
قالت: كنت أحب ولد أبي إليه، وإلى عمي أبي ياسر، لم ألقهما قط مع ولد لهما
إلا أخذاني دونه قالت: فلما قدم رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم المدينة،
ونزل قباء في بني عمرو بن عوف، غدا عليه أبي حيي بن أخطب، وعمي أبو ياسر
بن أخطب، مغلسين، قالت: فلم يرجعا حتى كانا مع غروب الشمس، قالت: فأتيا
كالين كسلانين ساقطين يمشيان الهوينى. قالت: فهششت إليهما كما كنت أصنع،
فواللَّه ما التفت إلى واحد منهما، مع ما بهما من الغم. قالت: وسمعت عمي
أبا ياسر وهو يقول لأبي حيي بن أخطب أهو هو؟ قال: نعم واللَّه، قال:
أتعرفه وتثبته؟قال: نعم، قال: فما في نفسك منه؟ قال: عداوته واللَّه ما
بقيت. ويشهد بذلك أيضاً ما رواه البخاري في إسلام عبد اللَّه بن سلام رضي
اللَّه عنه، فقد كان حبراً من فطاحل علماء اليهود، ولما سمع بمقدم رسول
اللَّه صلى الله عليه وسلم المدينة في بني النجار جاءه مستعجلاً، وألقى
إليه أسئلة لا يعلمها إلا نبي ولما سمع ردوده صلى الله عليه وسلم عليها
آمن به ساعته ومكانه، ثم قال له: إن اليهود قوم بهت، إن علموا بإسلامي قبل
أن تسألهم بهتوني عندك، فأرسل رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فجاءت
اليهود، ودخل عبد اللَّه بن سلام البيت. فقال رسول اللَّه صلى الله عليه
وسلم أي رجل فيكم عبد اللَّه سلام؟ قالوا: أعلمنا وابن أعلمنا، وأخيرنا
وابن أخيرنا وفي لفظ: سيدنا وابن سيدنا، وفي لفظ آخر: خيرنا وابن خيرنا
وأفضلنا وابن أفضلنا، فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أفرأيتم إن
أسلم عبد اللَّه؟ فقالوا: أعاذه اللَّه من ذلك مرتين أو ثلاثاً فخرج إليهم
عبد اللَّه فقال: أشهد أن لا إله إلا اللَّه وأشهد أن محمداً رسول اللَّه
فقالوا: شرنا وابن شرنا، ووقعوا فيه. وفي لفظ فقال: يا معشر اليهود اتقوا
اللَّه، فواللَّه الذي لا إله إلا هو إنكم لتعلمون أنه رسول اللَّه، وأنه
جاء بحق فقالوا: كذبت. وهذه أول تجربة تلقاها رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم
من اليهود، في أول يوم دخل فيه المدينة. هذا كله من حيث الداخلية، وأما من
حيث الخارجية فإن ألد قوة ضد الإسلام هي قريش، كانت قد جربت منذ عشرة
أعوام، حينما كان المسلمون تحت يديها، كل أساليب الإرهاب والتهديد
والمضايقة وسياسة التجويع والمقاطعة، وأذاقتهم التنكيلات والويلات، وشنت
عليهم حرباً نفسية مضنية مع دعاية واسعة منظمة، ثم لما هاجر المسلمون إلى
المدينة صادرت أرضهم وديارهم وأموالهم، وحالت بينهم وبين أزواجهم
وذرياتهم، بل حبست وعذبت من قدرت عليه، ثم لم تقتصر على هذا بل تآمرت على
الفتك بصاحب الدعوة صلى الله عليه وسلم والقضاء عليه، وعلى دعوته، ولم تأل
جهداً في تنفيذ هذه المؤامرة. وبعد هذا كله، لما نجا المسلمون إلى أرض
تبعد عنها خمسمائة كيلومتراً. قامت بدورها السياسي لما لها من الصدارة
الدنيوية والزعامة الدينية بين أوساط العرب بصفتها ساكنة الحرم ومجاورة
بيت اللَّه وسدنته، فأغرت غيرها من مشركي الجزيرة ضد أهل المدينة، حتى
صارت المدينة في شبه مقاطعة شديدة قلت مستورداتها في حين كان عدد اللاجئين
يزيد يوماً فيوماً، إن حالة الحرب قائمة يقيناً بين هؤلاء الطغاة من أهل
مكة وبين المسلمين في وطنهم الجديد، ومن السفه تحميل المسلمين أوزار هذا
الخصام. كان حقاً للمسلمين أن يصادروا أموال هؤلاء الطغاة كما صودرت
أموالهم، وأن يدالوا عليهم من التنكيلات بمثل ما أدالوا بها، وأن يقيموا
في سبيل حياتهم العراقيل كما أقاموها في سبيل حياة المسلمين، وأن يكال
لهؤلاء الطغاة صاعاً بصاع حتى لا يجدوا سبيلاً لإبادة المسلمين، واستئصال
خضرائهم. هذه هي القضايا والمشاكل التي كان يواجهها رسول اللَّه صلى الله
عليه وسلم حين ورد المدينة بصفته رسولاً هادياً وإماماً قائداً. وقد قام
رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بدور الرسالة والقيادة في المدينة، وأدلى
إلى كل قوم بما كانوا يستحقونه من الرأفة والرحمة أو الشدة والنكال، ولا
شك أن الرحمة كانت غالبة على الشدة والعنت، حتى عاد الأمر إلى الإسلام
وأهله في بضع سنوات، وسيجد القارىء كل ذلك جلياً في الصفحات الآتية بناء
مجتمع جديد: قد أسلفنا أن نزول رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بالمدينة
في بني النجار كان يوم الجمعة - ربيع الأول سنة ه الموافق - سبتمبر سنة -
م، وأنه نزل في أرض أمام دار أبي أيوب، وقال: ههنا المنزل إن شاء اللَّه،
ثم انتقل إلى بيت أبي أيوب. بناء المسجد النبوي: وأول خطوة خطاها رسول
اللَّه صلى الله عليه وسلم بعد ذلك هو إقامة المسجد النبوي. ففي المكان
الذي بركت فيه ناقته أمر ببناء هذا المسجد، واشتراه من غلامين يتيمين كان
يملكانه، وساهم في بنائه بنفسه، كان ينقل اللبن والحجارة ويقول: اللهم لا
عيش إلا عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة وكان يقول: هذا الحمال لا
حمال خيبر هذا أبرّ ربن ا وأطهر وكان ذلك مما يزيد نشاط الصحابة في البناء
حتى إن أحدهم ليقول: لئن قعدنا والنبي يعمل لذاك منا العمل المضلل وكانت
في ذلك المكان قبور المشركين، وكان فيه خرب ونخل وشجرة من غرقد، فأمر رسول
اللَّه صلى الله عليه وسلم بقبور المشركين فنبشت، وبالخرب فسويت، وبالنخل
والشجرة فقطعت، وصفت في قبلة المسجد، وكانت القبلة إلى بيت المقدس، وجعلت
عضادتاه من حجارة، وأقيمت حيطانه من اللبن والطين، وجعل سقفه من جريد
النخل، وعمده الجذوع، وفرشت أرضه من الرمال والحصباء، وجعلت له ثلاثة
أبواب، وطوله مما يلي القبلة إلى مؤخره مائة ذراع، والجانبان مثل ذلك أو
دونه، وكان أساسه قريباً من ثلاثة أذرع. وبنى بيوتاً إلى جانبه، بيوت
الحجر باللبن وسقفها بالجريد والجذوع، وهي حجرات أزواجه صلى الله عليه
وسلم ، وبعد تكامل الحجرات انتقل إليها من بيت أبي أيوب. ولم يكن المسجد
موضعاً لأداء الصلوات فحسب، بل كان جامعة يتلقى فيها المسلمون تعاليم
الإسلام وتوجيهاته، ومنتدى تلتقي وتتآلف فيه العناصر القبلية المختلفة
التي طالما نافرت بينها النزعات الجاهلية وحروبها، وقاعدة لإدارة جميع
الشؤون وبث الانطلاقات، وبرلماناً لعقد المجالس الاستشارية والتنفيذية.
وكان مع هذا كله داراً يسكن فيها عدد كبير من فقراء المهاجرين اللاجئين
الذين لم يكن لهم هناك دار ولا مال ولا أهل ولا بنون. وفي أوائل الهجرة
شرع الأذان، النغمة العلوية التي تدوي في الآفاق، كل يوم خمس مرات، والتي
ترتج لها أنحاء عالم الوجود. وقصة رؤيا عبد اللَّه بن زيد بن عبد ربه بهذا
الصدد معروفة، رواها الترمذي وأبو داود وأحمد وابن خزيمة. المؤاخاة بين
المسلمين: وكما قام النبي صلى الله عليه وسلم ببناء المسجد مركز التجمع
والتآلف. قام بعمل آخر من أروع ما يأثره التاريخ، وهو المؤاخاة بين
المهاجرين الأنصار، قال ابن القيم ثم آخى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم
بين المهاجرين الأنصار، في دار أنس بن مالك، وكانوا تسعين رجلاً، نصفهم من
المهاجرين، ونصفهم من الأنصار، آخى بينهم على المواساة، ويتوارثون بعد
الموت دون ذوي الأرحام، إلى حين وقعة بدر، فلما أنزل اللَّه عز وجل:
{وَأُوْلُوا الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ} [الأنفال: 75>،
الأنفال - رد التوارث، دون عقد الأخوة. وقد قيل إنه آخى بين المهاجرين
بعضهم مع بعض مؤاخاة ثانية. والثبت الأول، والمهاجرين كانوا مستغنين بأخوة
الإسلام وأخوة الدار وقرابة النسب عن عقد مؤاخاة بخلاف المهاجرين مع
الأنصار ا هـ. ومعنى هذا الإخاء كما قال محمد الغزالي أن تذوب عصبيات
الجاهلية فلا حمية إلا للإسلام، وأن تسقط فوارق النسب واللون والوطن، فلا
يتقدم أحد أو يتأخر إلا بمروءته وتقواه. وقد جعل الرسول صلى الله عليه
وسلم هذه الأخوة عقداً نافذاً لا لفظاً فارغاً وعملاً يرتبط بالدماء
والأموال، لا تحية تثرثر بها الألسنة ولا يقوم لها أثر. وكانت عواطف
الإيثار والمواساة والمؤانسة تمتزج في هذه الأخوة، وتملأ المجتمع الجديد
بأروع الأمثال. فقد روى البخاري أنهم لما قدموا المدينة آخى رسول اللَّه
صلى الله عليه وسلم بين عبد الرحمن وسعد بن الربيع، فقال لعبد الرحمن إني
أكثر الأنصار مالاً، فاقسم مالي نصفين، ولي امرأتان، فانظر أعجبهما إليك
فسمها لي، أطلقها، فإذا انقضت عدتها فتزوجها، قال: بارك اللَّه لك في أهلك
ومالك، وأين سوقكم؟ فدلوه على سوق بني قينقاع، فما انقلب إلا ومعه فضل من
أقط وسمن، ثم تابع الغدو، ثم جاء يوماً وبه أثر صفرة، فقال النبي صلى الله
عليه وسلم مهيم؟ قال: تزوجت. قال: كم سقت إليها؟ قال: نواة من ذنب. وروى
عن أبي هريرة قال: قالت الأنصار للنبي صلى الله عليه وسلم اقسم بيننا وبين
إخواننا النخيل. قال: لا. فقالوا: فتكفونا المؤنة ونشرككم في الثمرة قالوا
سمعنا وأطعنا. وهذا يدلنا على ما كان عليه الأنصار من الحفاوة البالغة
بإخوانهم المهاجرين، ومن التضحية والإيثار والود والصفاء، وما كان عليه
المهاجرون من تقدير هذا الكرم حق قدره فلم يستغلوه ولم ينالوا منه إلا
بقدر ما يقيم أودهم. وحقاً فقد كانت هذه المؤاخاة حكمة فذة، وسياسة صائبة
حكيمة، وحلاً رائعاً لكثير من المشاكل التي كان يواجهها المسلمون، والتي
أشرنا إليها. ميثاق التحالف الإسلامي: وكما قام رسول اللَّه صلى الله عليه
وسلم بعقد المؤاخاة بين المؤمنين، قام بعقد معاهدة أزاح بها كل ما كان من
حزازات الجاهلية، والنزعات القبلية، ولمن يترك مجالاً لتقاليد الجاهلية،
وهاك بنودها ملخصاً: هذا كتاب من محمد النبي صلى الله عليه وسلم بين
المؤمنين والمسلمين من قريش ويثرب ومن تبعهم فلحق بهم، وجاهد معهم أنهم
أمة واحدة من دون الناس. المهاجرون من قريش على ربعتهم يتعاقلون بينهم،
وهم يفدون عانيهم بالمعروف والقسط بين المؤمنين، وكل قبيلة من الأنصار على
ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى، وكل طائفة منهم تفدى عانيها بالمعروف
والقسط بين المؤمنين. وأن المؤمنين لا يتركون مفرحاً بينهم أن يعطوه
بالمعروف في فداء أو عقل. وأن المؤمنين المتقين على من بغى عليهم، أو
ابتغى دسيعة ظلم أو إثم أو عدوان أو فساد بين المؤمنين. وأن أيديهم عليه
جميعاً، ولو كان ولد أحدهم. ولا يقتل مؤمن مؤمناً في كافر. ولا ينصر
كافراً على مؤمن. وان ذمة المسلمين واحدة يجير عليهم أدناهم. وأن من تبعنا
من يهود فإن له النصر والأسوة غير مظلومين ولا متناصرين عليهم. وأن سلم
المؤمنين واحدة لا يسالم مؤمن دون مؤمن في قتال في سبيل اللَّه إلا على
سواء وعدا بينهم. وأن المؤمنين يبيء بعضهم على بعض بما نال دماءهم في سبيل
اللَّه. وأنه لا يجير مشرك مالاً لقريش ولا نفساً، ولا يحول دونه على
مؤمن. وأنه من اعتبط مؤمناً قتلا عن بينة فإنه قود به، إلا أن يرضى ولي
المقتول. وأن المؤمنين عليه كافة ولا يحل لهم إلا قيام عليه. وأنه لا يحل
لمؤمن أن ينصر محدثاً ولا يؤويه، وأنه من نصره أو آواه فإن عليه لعنة
اللَّه وغضبه يوم القيامة، ولا يؤخذ منه صرف ولا عدل. وأنكم مهما اختلفتم
فيه من شيء فإن مرده إلى اللَّه عز وجل وإلى محمد صلى الله عليه وسلم. أثر
المعنويات في المجتمع: بهذه الحكمة، وبهذا الحذاقة أرسى رسول اللَّه صلى
الله عليه وسلم قواعد مجتمع جديد، ولكن كانت هذه الظاهرة أثراً للمعاني
التي كان يتمتع بها أولئك الأمجاد بفضل صحبة النبي صلى الله عليه وسلم ،
وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعهدهم بالتعليم والتربية وتزكية النفوس
والحث على مكارم الأخلاق، ويؤدبهم بآداب الود والإخاء والمجد والشرف
والعبادة والطاعة. سأله رجل: أيّ الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام، وتقرىء
السلام على من عرفت ومن لم تعرف. قال عبد اللَّه بن سلام: لما قدم النبي
صلى الله عليه وسلم المدينة جئت فلما تبينت وجهه، عرفت أن وجهه ليس بوجه
كذاب، فكان أول ما قال: "يا أيها الناس أفشوا السلام، وأطعموا الطعام،
وصلوا الأرحام، وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام". وكان يقول
"لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه". ويقول: "المسلم من سلم المسلمون
من لسانه ويده". ويقول: "لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه".
ويقول: "المؤمنون كرجل واحد، إن اشتكى عينه اشتكى كله، وإن اشتكى رأسه
اشتكى كله". ويقول: "المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً". ويقول: "لا
تباغضوا، ولا تحاسدوا، ولا تدابروا، وكونوا عباد اللَّه إخواناً ولا يحل
لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام". ويقول: "المسلم أخو المسلم لا يظلمه
ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان اللَّه في حاجته، ومن فرج عن مسلم
كربة فرج اللَّه عنه كربة من كربات يوم القيامة، ومن ستر مسلماً ستره
اللَّه يوم القيامة". ويقول: "ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء".
ويقول: "ليس المؤمن بالذي يشبع وجاره جائع إلى جانبه". ويقول: "سباب
المؤمن فسوق، وقتاله كفر". وكان يجعل إماطة الأذى عن الطريق صدقة، وبعدها
شعبة من شعب الإيمان. وكان يحثهم على الإنفاق، ويذكر من فضائله ما تتقاذف
إليه القلوب، فكان يقول: "الصدقة تطفىء الخطايا كما يطفىء الماء النار.
ويقول: "أيما مسلم كسا مسلماً ثوباً على عري، كساه اللَّه من خضر الجنة،
وأيما مسلم أطعم مسلماً على جوع أطعمه اللَّه من ثمار الجنة، وأيما مسلم
سقا مسلماً على ظمأ سقاه اللَّه من الرحيق المختوم". ويقول: "اتقوا النار
ولو بشق تمرة، فإن لم تجد فبكلمة طيبة". وبجانب هذا كان يحث حثاً شديداً
على الاستعفاف عن المسألة، ويذكر فضائل الصبر والقناعة، كان يعد المسألة
كدوحاً أو خدوشاً أو خموشاً في وجه السائل. اللهم إلا إذا كان مضطراً، كما
كان يحدث لهم بما في العبادات من الفضائل والأجر والثواب عند اللَّه، وكان
يربطهم بالوحي النازل عليه من السماء ربطاً موثقاً يقرؤه عليهم، ويقرؤونه،
لتكون هذه الدراسة إشعاراً بما عليهم من حقوق الدعوة، وتبعات الرسالة،
فضلاً عن ضرورة الفهم والتدبر. وهكذا رفع معنوياتهم ومواهبهم، وزودهم
بأعلى القيم والأقدار والمثل، حتى صاروا صورة لأعلى قمة من الكمال عرفت في
تاريخ البشر بعد الأنبياء. يقول عبد اللَّه بن مسعود رضي اللَّه عنه من
كان مستناً فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة اولئك أصحاب
محمد صلى الله عليه وسلم ، كانوا أفضل هذه الأمة، أبرها قلوباً، وأعمقها
علماً، وأقلها تكلفاً، اختارهم اللَّه لصحبة نبيه ولإقامة دينه، فاعرفوا
لهم فضلهم، واتبعوهم على أثرهم، وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم وسيرهم،
فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. ثم إن هذا الرسول القائد الأعظم صلى الله
عليه وسلم كان يتمتع من الصفات المعنوية والظاهرة ومن الكمالات والمواهب
والأمجاد والفضائل ومكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال بما جعلته تهوي إليه
الأفئدة، وتتفانى عليه النفوس، فما يتكلم بكلمة إلا ويبادر صحابته رضي
اللَّه عنه إلى امتثالها، وما يأتي برشد وتوجيه إلا ويتسابقون إلى التحلي
به. بمثل هذا استطاع صلى الله عليه وسلم أن يبني في المدينة مجتمعاً
جديداً أروع وأشرف مجتمع عرفه التاريخ، وأن يضع لمشاكل هذا المجتمع حلاً
تتنفس له الإنسانية الصعداء، بعد أن كانت تعبت في غياهب الزمان ودياجير
الظلمات. وبمثل هذه المعنويات الشامخة تكاملت عناصر المجتمع الجديد الذي
واجه كل تيارات الزمان حتى صرف وجهتها، وحول مجرى التاريخ والأيام.